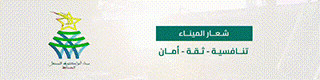------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسوله والسلام
إن الرغبة الصادقة الداعية إلى التنويه بمآثر أبناء هذه البلاد، هي التي أتاحت لنا مناسبة الملتقى الوافر الحضور، المنعقد منذ أمس، وتلك مبادرة تستحق الإشادة وتقديم جزيل الشكر عليها إلى أولئك الذين سعوا وأفلحوا في إنجازها، وحبذا لو أصبحت فاتحة سنّة لإحياء ذكرى مَن رفعوا اسم بلاد شنكيطي عالياً في ميدان المعارف الإسلامية والعربية وفي مجال التصوف والنشاط الروحي. وبلاد شنكيطي –وسيتكرر ذكرها- هي، كما تدركون، ذلك القطر الذي كان مهد حركة المرابطين والذي انتشرت فيه اللهجة العربية الحسانية، ويشمل أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية ونواحي أخرى تخضع لسيادة دول مجاورة. أنجب هذا الإقليم زمرة من العلماء والمتصوفة العارفين على مدى القرون الخمسة الأخيرة، مما بوأه مكانة لها شأن في محيط المعرفة.
وعن أحد هؤلاء النوابغ، ألا وهو الشيخ سيدي وأسرته، يجري حديث المنتدى الحالي. نعم لم يكن ينتظر من أهالي قطر قصي، فرضت أوضاعه المناخية على قاطنيه حياة الظواعن والنظام العشائري البدائي: أجل لم يكن ينتظر منهم إسهام ذو بال في إثراء المعارف. وجاءت المفاجأة بتغلب هذا الشعب على التحدي الذي رمته به الأقدار فأصبح المجموعة الفريدة من بين الرحل التي احتضنت تقاليد ثقافية مكتوبة أكسبته شخصية متميزة تضاهي النظائر التي عاصرتها في سائر أرجاء العالم الإسلامي. وقد تحدث مقدمو الأبحاث عن جوانب شخصية الشيخ سيدي المتعددة وعن أسرته، وقد حصلت الإفادة، فلا داعي لتكرار ما مر بمسامعكم، وإنما يحاول العرض التالي استكمال الصورة بإلقاء بعض الأضواء على المسار الاجتماعي الثقافي، خلال الخلفية التاريخية طويلة الأمد، التي كان من ثمارها مجتمع أنجب رجالا من أمثال الشيخ سيدي، وبذلك يتضح ارتباط أدوار ماضي هذه الديار بعضها ببعض.
تأسست بنية المجتمع الذي أقام لهذه البلاد مكونات شخصيتها على مراحل يتراءى لمتتبعها حصر أبرز الأحداث التي شهدتها في الأدوار التالية: بدء التبشير بالإسلام، ثم حركة المرابطين وتالياً انتشار اللسان العربي. استهلت البلاد طريقها تحت أنوار أضخم معالم التاريخ، فقد وصلت طلائع الفتح العربي الإسلامي إلى الطرف الشمالي مما سيُدعى لاحقاً باسم بلاد شنكيطي، حدث ذلك على عهد الخليفة هشام بن عبد الملك وولاية عبيد الله بن الحبحاب لإفريقية (116-123هـ/734-741م). كان أول من اتصل به الغزاة هنالك قبائل من صنهاجة "أولي الضفائر، الملتزمين اللثام"، كما نعتتهم أقدم الروايات التي دونها الإخباريون ومؤلفو المسالك والممالك.
وقد اخترقت إحدى الحملات، تلك الأيام، الصحراءَ حتى بلغت مصب "النيل" لنهر السينكال في المحيط وهكذا سجلت صفحات التاريخ، لأول مرة، ظهور هذه البلاد، علماً بخلو الأدبيات –اليونانية– اللطينية من ذكرها في الفترة السابقة.
تسربت بواكير الدعوة الإسلامية من الأقطار التي أصبحت تضمها دار الإسلام إلى ما وراءها من الصحراء، وسيكون الفضل في بث تعاليم الرسالة من نصيب التجار المسلمين المترددين، عبر مجالات صنهاجة، بين الشمال الإفريقي وبلاد السودان الغربي. يلي هذا الدور في الأهمية قيام حركة المرابطين قبل ألف مضت من الأعوام، حوالي سنة 420هـ/1029م، وقد رافق نشأة المرابطين اعتناق مجاوريهم، أهالي سلى وتكرور، للإسلام فكانوا لهم عوناً وظهيراً على مجابهة الأزمات التي عصفت بدعوتهم في مراحلها الأولى وأوشكت القضاء عليها. حفظ لنا هذا النبأ الهام نص من رسائل أبي محمد علي بن أحمد بن حزم (توفي سنة 456هـ/1063م).
خلّف المرابطون في مجتمعنا سمات لا تزال تميزه عن مثيلاته، ولم تع الذاكرة من هذا الحدث الجسيم إلا ما حاك الخيال الشعبي من مأثورات جاءت مخالفةً للواقع التاريخي، إذ أتت به مقلوباً رأساً على عقب، حيث جعلت المرابطين جماعةً من الغزاة يهجمون على مهدهم. وإطناباً في الغرابة، عزت إليهم تأسيس مجتمع مراتبي يتألف من شرائح حملت السلاح والمنقطعين إلى العلم وشؤون الدين وأتباع أسند إليهم تأمين وسائل العيش للطائفتين! وغني عن البيان أن المجتمع المتمثل في هذه الفئات كان وليد تأثيرات وصراعات تطلبت قروناً لتبرز إلى حيز الوجود.
وفيما يخص "الزوايا"، وهو جمع "مرابط" من غير لفظه في اللهجة كظاهرة، فقد كان إطلالهم على مسرح الواقع الاجتماعي نتيجة مسيرة بطيئة. فاسم المرابطين ظل طيلة عصور يطلق على أعقاب المنتسبين إلى الدعوة التي نادى بها عبد الله بن ياسين، وكانوا في جملتهم محاربين حملة سلاح ولا علاقة لهم بما أصبح سمة لـ"الطلبة"، كالتخلي عن حمل السلاح والتخصص بشؤون الدين، وبما يدعى "الهيمنة على المغيبات".
اتجهت الحركة شطر الشمال وأقامت هناك الدولة التي تكفلت مدونات التاريخ والأبحاث العصرية في شتى اللغات الإشادة بأعمالها، وجرت في صفوفها حشوداً من بني جلدة القائمين بها ستستوعبهم الأقطار المفتوحة، ويبدو أنهم قد أهملوا جناحهم المتبقي في مهدهم.
ختم هذا المسلسل طروق ذوي حسان أطراف البلاد، ففي السنوات التي اشتد فيها ساعد المرابطين وشرعوا في الاستيلاء على المغرب، نجم من ناحية المشرق حدث سيكون له شأن في مصائر البلاد. كان ذلك "تغريبة" هلال وسليم ترافقهم طوائف من الأعراب من بينها معقل الذين ينتمي إليهم ذوو حسان. وبعدما يربو على قرنين وردت أقدم إشارة إلى اسمهم مقرونا باسم الساقية الحمراء (أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي).
وتقضي قاعدة مطردة على قبيل الظواعن الذي تطأ أقدامه منطقة "الساقية" متابعة سيره نحو الجنوب – من جراء سوء الحظ في الحروب أو على أثر التغيرات المناخية – حتى تنشب في أظفاره يوماً ما أشواك "إينيتي"، ذلك العشب النامي في القطاع المداري اللاصق بجنوب الصحراء، حيث انتشرت طوائف هؤلاء الأعراب على مراحل في أرجاء البلاد برمتها قبل نهاية القرن 9هـ/15.
وبذلك استكمل القطر عناصر سكانه، وحلت لهجتهم الحسانية محل اللهجات الصنهاجية (كلام ازناكة) في طول "تراب البيضان" وعرضها، فغدا اكتساب الدربة على إتقان الفصحى واستخدامها أيسر من ذي قبل.
وندرك أبعاد هذا التحول الثقافي إذا ما عارضنا أسلوب مؤلفات علماء السوس وأدبائه، وما كتب فقهاء التوارك، بالدرجة العالية من تملك أمثالهم لدينا ناصية اللغة ومرونة الأداء بها، مما يتجلى في إبداع أدب عربي صميم، احتل مكانة مرموقة بين آداب هذه اللغة. هكذا تم خلال هذه القرون التلاحم بين السابقين في الاستيطان والطارئين عليهم. وكما نفذت تعاليم الإسلام إلى أعماق القلوب وصبغت تنظيمات المجتمع وقيمه بمتطلباتها، أتاح التطور الذي عاشته الجماعات نشأة المعارف المتداولة من علوم الدين والثقافة العربية ورسوخها. وقد سار هذا النشاط جنباً إلى جنب مع التيار الصوفي الذي أخذ شكل الطرق تجاوباً مع أذواق الجمهور، وذلك ما دعاه بعض الباحثين بظاهرة "التمربط". ومن أوضح الأمثلة على المنحى الذي اتجه إليه التصوف أثناء القرنين التاسع والعاشر للهجرة/ الخامس عشر والسادس عشر للميلاد، انتشار شهرة "مرابطي الساقية الحمراء" (وهو اسم أطلق آنذاك على بلادنا ولم يكتب له البقاء)، وتنتمي إلى هؤلاء "المرابطين" عدة عشائر في قطرنا، كما خلفوا أعقابا –أو من يدعي ذلك– وصيتا على طول طريق الحج من السوس إلى طرابلس الغرب.
كان دور هؤلاء "المرابطين الجدد" بمثابة إسهام بلادنا في الحركة الواسعة التي شملت بلدان المغرب الإسلامي ووجهت مصيرها الروحي والاجتماعي إلى أن تدخل الاستعمار الأوروبي في القرن 13هـ/19م. وكذلك نستطيع اعتبار هذا الدور بمنزلة إرهاصات لما سيقوم به علماء ومتصوفة بلدنا في حقبة تالية.
لا تتوفر معطيات يمكن على ضوئها تتبع مراحل سير الحياة الثقافية على طول الخطين: علوم الظاهر والتصوف. ونعثر بالصدفة على اسم مريد شنكيطي أخذ عن الشيخ أحمد زروق، أحد أقطاب الشاذلية (846-899 إلى القرن 10هـ/16م). ولدينا إشارات إلى فقهاء عاشوا في ولاته ووادان تعود إلى القرن 10هـ/16م، ونلمس، على ما يتراءى لنا، درجة من الاكتفاء بَلغتْها البلاد في مجال العلوم المتداولة، فاستغنى بذلك طلبة العلم عن الرحلة إلى شيوخ الأمصار الإسلامية –ومنها تنبكتو- إذ أصبحوا يجدون محلياً مَن تتوفر فيهم أهلية الأخذ عنهم. وتدل الإجازات التي درج علماء بلدنا على منحها تلاميذَهم إلى ذلك النضوج، إذ تحتوي ابتداءً على أسماء محليين قبل أن تصعد الرواية إلى رجال السند من مغاربة ومصريين ومجاوري الحرمين الذين كانت الرحلة إليهم. آتت التأثيرات التي ضمنت رحلات الحج وطلب العلم استمرار ورودها، أُكلها، فلم يطل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، حتى أخذ نبوغ جلة من العلماء ورجال التصوف يتوالى في مختلف أنحاء البلاد، ومن بينهم مشاهير يعتبرون من مفاخر بلاد شنكيطي، وقد احتوى كتاب فتح الشكور على تراجم العديد منهم.
****
آلت المسيرة التي ألمحنا إليها إلى نبوغ أجيال من رجال العلم والتصوف يعدون رموز درجة النضوج الفكري التي وصل إليها قطر شنكيطي، وقد تركوا أثراً عميقاً في محيط المعرفة والتصوف، ولا يسع المقام تعدادهم، وسنجتزئ بذكر بعض أعلامهم ممن عاشوا في القرنين 12و13هـ/18و19م، وذلك لصلتهم بالجو الثقافي الذي كان من نتاجه شخصية الشيخ سيدي، فهذا المختار بن بونا الجكني، مؤسس مدرسة المعارف العربية والإسلامية التي لا زالت التقاليد المتبعة في "المحاضر" تتقيد بها، ومن أبرز تلاميذه حرمة بن عبد الجليل العلوي، وعليه درس الشيخ سيدي، وهذا سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي، وقد حرص الشيخ سيدي على لقائه، ثم الشيخ سيدي المختار الكنتي، زعيم الطائفة الصوفية المستندة إلى درجة عالية من علوم الظاهر، ويتلوه ابنه الشيخ سيدي محمد، شيخ الشيخ سيديّ. وإلى جيل معاصر ينتمي الشيخ محمد الحافظ العلوي الذي دخلت الطريقة التيجانية هذه الأقطار على يديه.
لعل تلاقي تيارات الينابيع الروحية والمعرفية التي مر بها خاطفا العرض السابق يساعد على فهم أبعاد العمق الثقافي الاجتماعي الذي نشأ فيه الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبة الأبييري (حدود 1190- سلخ ذي الحجة 1284هـ/1776-23 ابريل 1868م)، ولا نعيد الحديث عن تفاصيل حياته، فقد مر التنبيه إلى عدم الحاجة لذلك، لكن هناك جانب من جوانب هذه الشخصية الفذة من المفيد الإلمام به، لما له من علاقة بالدور الذي لعبه في مجتمع عصره. فقد لمع الشيخ سيدي كعالم واسع الباع وكصوفي عميق الإدراكات، تشهد على ذلك آثار قلمه الوافرة وشمولها، وقد استوعب تكوينه حصيلة التيارات التي سلف الحديث عنها، وانثالت عليه جموع من طلبة العلم والمريدين الراغبين في سلوك "طريق القوم"، فحملوا عنه العلم الجم وترضوا بتربيته اليقظة التي أحيت قلوباً ووجهت خلائق. وإلى جانب ما تحلى به الشيخ سيدي من المواهب العلمية والروحية، برز منه رجل صلب المنة ماضي العزم وثاب الهمة، بهر العديد من معاصريه ليس فقط بما جرى على يديه من خوارق وكرامات كان المجتمع مستعداً لتقبلها، بل بالرأي الصائب وحصافة العقل، أهلته تلك الخلال لاحتلال درجة من الزعامة لم يتح إلا لنفر قليل من رجال العلم والدين بلوغها في هذه الأقطار. وتبرهن نشاطات الشيخ التي يقوم شاهدا عليها وفرة رسائله وفتاويه في المجال الديني والسياسي على الهمة العالية والسعي فيما يراه صالحاً على امتداد عمره –ما وسعه الأمر– فقد تدخل في شؤون القبائل وتوسط بين هؤلاء وأولئك، ولم يجره اتساع نفوذه إلى النداء بإحدى تلك الحركات التي طالما أغرت الكثير من رجال الدين، ومنهم مَن عاصروه، بالدعوة إلى محاولة الاستيلاء على الحكم باسم الإسلام، وما ذلك إلا إدراكاً منه لانعدام الأوضاع الملائمة في مجتمع يسوده النظام العشائري، وهو العقبة المتعرضة في طريق محاولة الإصلاح وجمع الكلمة، بل ظلت جهوده في غالب الأحيان تقف عند حدود الإقناع ببذل النصائح والأمر بالمعروف، وهي وإن لم تتكلل دائماً بالنجاح، فلم يثنه ذلك عن الصمود على السير في الطريق الذي رآه من واجب الأمانة التي حمل الله العلماءَ مقاليدَها، وهو تعبير يتردد في العديد من رسائله وتآليفه، فقام بإنجاز ما استطاع دون أن يحوز على أي ضرب من الحكم. ويتراءى للناظر أن القوة الدافعة لهذه الشخصية تكمن في عمق إيمانه وإحساسه الحي بقيمة التعاليم الصوفية، فهذان الحافزان خالطا نياط قلبه ووجها تفكيره وشعوره وسلوكه.
التراث الحي
يتمثل التراث في أحد جوانبه في حياة وسيرة أحفاد الشيخ سيدي، فقد برز منهم حاملو الكل الذي نهض به، أما ابنه الشيخ سيدي محمد (1245-ذي الحجة 1285هـ/1830- مارس 1869م) فلم يلبث بعد والده إلا سنة تنقصها أيام، وقد شوهد منه النهوض بأعباء رسالة والده في المجالات التي قام عليها، وجاء دور الحفدة، الشيخ سيدي باب (1277- جمادى الثانية 1342هـ/1860- يناير 1924م) والشيخ سيدي المختار (1278- رجب 1370هـ/1861- ابريل 1951م). وقد قضى الشقيقان حياتهما في وئام تام وتوزعا بينهما المهام التي ألقاها على عواتقهما الواجب الذي خلفه الشيخ سيدي، وقد ألمت بتفاصيل مفيدة عن ذلك الأبحاثُ التي استمعتم إليها. ولقد اتخذت حياتهما، بل وحياة البلاد بأسرها، منعطفاً جديداً باستيلاء الفرنسيين على موريتانيا. وشاءت الأقدار أن تكون السنة التي ولد فيها الشيخ سيدي باب هي نفس السنة التي اتفقت فيها فرنسا وإنكلترة على مصير هذه البلاد، فتخلت إنكلترة لفرنسا عما كان معترفا لها به في المعاهدات القديمة من حق ممارسة تجارة العلك (الصمغ العربي) على شواطئ المحيط الموريتانية، مقابل تسليم فرنسا لها المقر التجاري الذي كانت أقامته في غامبيا: وأصبح الباب مفتوحاً لفرنسا حتى تستولي على هذه البلاد في الوقت المناسب لها دون اعتراض منافستها إنكلترة.
ودعا جهل هذه الملابسات في السياسة الدولية بعض حملة الأقلام والأقوال إلى اتهام الشيخ سيدي باب في حدث جرت بوادره والتهيؤ له والعزم عليه قبل ميلاده، وأدانه هؤلاء أن يكون له ضلع في الاحتلال الفرنسي، إغفالا للواقع: وهو أن الفرنسيين كانوا يعتبرون أن أصحاب الشوكة من القبائل المسلحة هم أصحاب السلطة على البلاد وهم الذين كانوا يعقدون معهم اتفاقية في القرون التي سبقت احتلالهم، لذلك عقدوا اتفاقاً بمقتضاه سلمت جماعة الترارزة مقاليد أمور بلادهم إلى ممثل السلطة الفرنسية، وكان دور الشيخ سيدي باب وبصحبته الشيخ سعد بوه بن الشيخ محمد فاضل، دور الشاهد على العقد فقط.
هذا ما كان يجب إيضاحه لتقويم الأغلاط الشائعة، ويضاف إلى ذلك أن الشيخ سيدي باب قد بين موقفه بكل وضوح في رسائله وفتاويه، وقد سانده العديد من علماء البلاد من أبرزهم ابنا مايابي الجكنيان بعد أن كانا اختلفا معه قبل هجرتهما إلى المغرب والمشرق، ورسائلهما إليه في القضية محفوظة في مكتبة أهل الشيخ سيدي. وينبغي في هذا المجال الاطلاع على رسالة سيدي أحمد بن الأمين مؤلف الوسيط، والرسالة كتبها إلى قريبه السالك بن باب بن أحمد بيبه العلوي.
استمر الشيخ سيدي باب بقية حياته في ظل الاحتلال الفرنسي، إلى جانب شقيقه، ساعياً في بذل جهوده فيما يراه مصلحةً للإسلام والمسلمين، ونزولا إلى ضرورات الوضع الراهن، وقد رفض تناول أي راتب من الإدارة الفرنسية أو حمل أي وسام عرضوه عليه حتى توفاه الله. ويحلو لي في الختام أن أعبر عن شعوري بالتفاؤل أمام مستقبل بلاد أنجبت رجالا كالشيخ سيدي وأمثاله، فإن مجتمعاً تظهر في تضاعيف قطاعاته أمثال هذه الشخصية الفذة ليبعث على واسع الآمال في مستقبله ويُنهِض الهمم ويحمل على الاعتقاد بإمكانات مخبوءة تنتظر الفرص المواتية للبروز، ذلك هو التراث الذي خلفه للأجيال التالية الشيخ سيدي والذين ساروا على شاكلته ونهجه.
محمد ولد مولود ولد داداه (الشنافي)
من صفحة
محمد ولد المنى