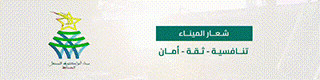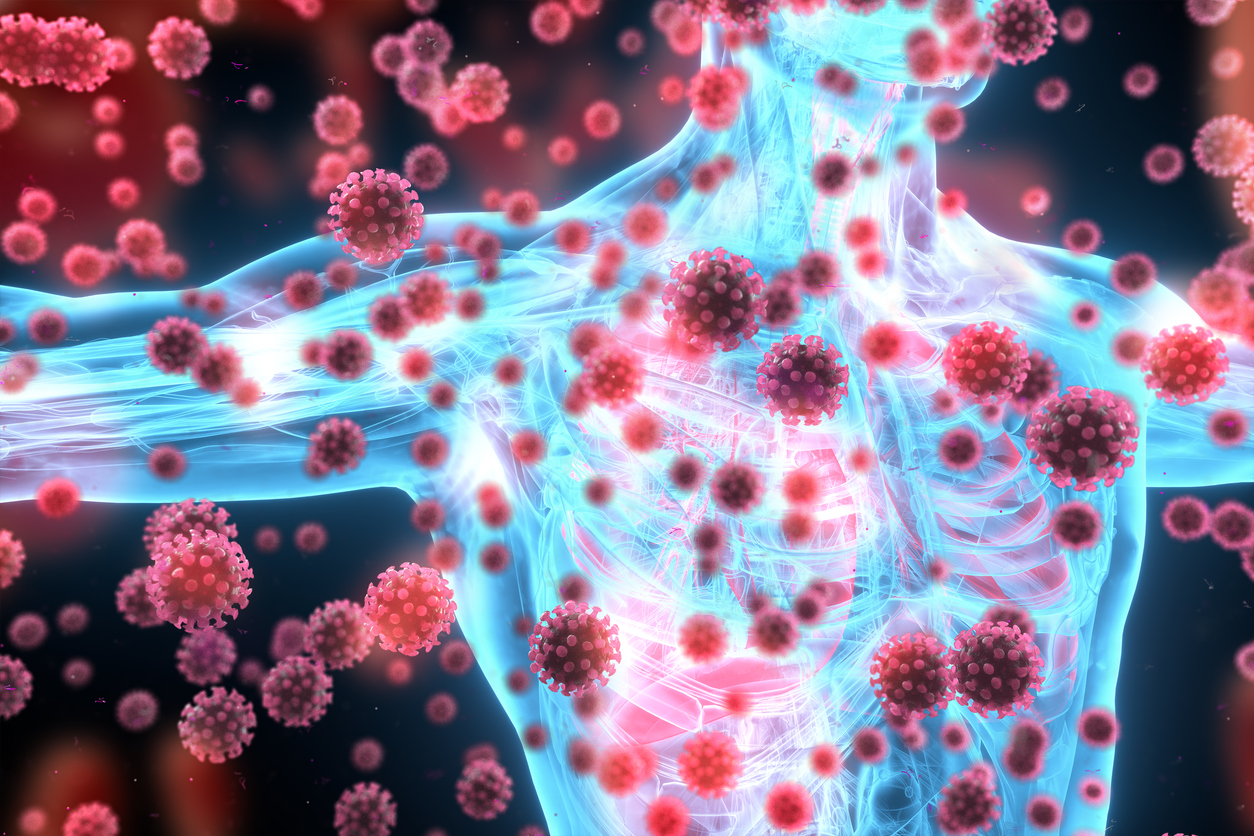
لنتخيل كوكب الأرض وهو خالٍ من الفيروسات.
إذْ لوّحنا بعصا سحرية، فاختفت جميعها. اختفى فيروس داء الكلَب فجأة. واختفى فيروس شلل الأطفال. واختفى فيروس إيبولا الفتاك. واختفى أيضا فيروس الحصبة، وفيروس النكاف، وفيروسات الإنفلونزا المختلفة. فتقلصت معاناة البشر كثيرًا وقَلّت وفياتهم. واختفى فيروس نقص المناعة البشرية؛ ولذا لم تقع كارثة الإيدز أبدًا. واختفت فيروسات "نيباه" و"هيندرا" و"ماتشوبو" و"سين نومبري".. بصرف النظر عمّا أحدثت من فتك مقيت. واختفت حمى الضنك. واختفت كل الفيروسات العَجَلية (فيروسات روتا)؛ وذلك مبعث رحمة كبيرة للأطفال في البلدان النامية الذين يموتون بمئات الآلاف في كل عام. واختفى فيروس زيكا. واختفى فيروس الحمى الصفراء. واختفى فيروس هربس "ب" الذي تحمله بعض القردة وغالبًا ما يكون فتاكًا عند انتقاله إلى البشر. ولم يعد أي أحد يعاني جدري الماء ولا التهاب الكبد ولا الهربس النطاقي ولا حتى نزلات البرد العادية. وماذا عن فيروس الجدري، العامل المسبب لداء الجدري؟ تم القضاء على هذا الفيروس في الطبيعة بحلول عام 1977، لكنه اختفى الآن كذلك من المجمِّدات عالية الأمان حيث تُخزَّن آخر عيِّناته المخيفة. واختفى فيروس سارس الذي ظهر في عام 2003، وهو ناقوس الخطر الذي نعرف الآن أنه كان مؤشرًا إلى عهد الجوائح الحديث. وبطبيعة الحال، اختفى فيروس "سارس-كوف2-" الفظيع، المسبب لوباء "كوفيد19-"، والمتغير في تأثيراته على نحو يثير الحيرة، والمخادع إلى درجة كبيرة، والخطير للغاية، والقابل للانتقال والانتشار السريع. فهل تشعر الآن بالارتياح؟ إياك أن تميل إلى هذا الشعور!
إنه سيناريو أكثر التباسًا مما تَظن. فالواقع هو أننا نعيش في عالم من الفيروسات.. فيروسات متنوعة إلى حدّ يستعصي على الفهم، ووفيرة العدد إلى حد يفوق الحصر. فمن الممكن أن تحتوي المحيطات وحدها على جسيمات فيروسية أكثر من النجوم في الكون المرئي. وقد تحمل الثدييات ما لا يقل عن 320 ألف نوع مختلف منها. وعندما تُضاف تلك التي تصيب الحيوانات غير الثديية والنباتات والبكتيريا الأرضية وكل مضَيِّف آخر محتمل، فإن المجموع يصل إلى.. عدد غزير للغاية. وخلف هذه الأعداد الكبيرة تكمن تأثيرات كبيرة: فكثير من هذه الفيروسات يجلب معه فوائدَ تأقلمٍ -لا أضرار- للحياة على الأرض، بما في ذلك الحياة البشرية. وما كان لحياتنا أن تستمر من دونها. ولم نكن لنخرج من الوحل البدائي من دونها. فقد نشأ من الفيروسات طولان لجزيئات الحمض النووي يستقران اليوم في جينومات البشر ورئيسات أخرى، ومن دونهما -وهذه حقيقة مذهلة- سيكون الحمل مستحيلا. وهناك الحمض النووي الفيروسي الذي تحتضنه مورّثات (جينات) الحيوانات البرية ويساعد على تجميع الذكريات وتخزينها -وهذه حقيقة مذهلة أخرى- في فقاعات بروتينية صغيرة. ولا تزال مورّثات أخرى مكتسبة من الفيروسات تسهم في نمو الأجنة وتنظيم الجهاز المناعي ومقاومة السرطان؛ وهي تأثيرات مهمة لم نبدأ فهمها إلا في الآونة الأخيرة.
فقد اتضح أن الفيروسات قامت بأدوار حاسمة في إطلاق العنان لتحولات كبرى في تاريخ التطور. ومن شأن التخلص من جميع الفيروسات، كما رأينا في السيناريو المتخيَّل آنفًا، أن يتسبب في انهيار التنوع البيولوجي الهائل الذي ينعم به كوكبنا.. تمامًا كما يحدث لمنزل خشبي جميل عندما يُخلع كل مسمار منه على نحو مفاجئ. أجل؛ إن الفيروس طفيلي في حد ذاته، لكن هذا التطفل يكون في بعض الأحيان أشبه بالتعايش التكافلي أو الاعتماد المتبادل الذي يفيد الزائر والمضَيِّف على حد سواء. فالفيروسات كمثل النار: لا هي بالنعمة في كل الأحوال ولا بالنقمة دائمًا؛ إذ يمكنها أن تجلب المنفعة القصوى أو الدمار. ويتوقف كل ذلك على نوع الفيروس، وعلى الحالة، وعلى الأساس المرجعي للشخص. إنها ملائكة التطور الخفية والرائعة والفظيعة؛ وذلك ما يجعلها مثيرة للاهتمام.
ولإدراك تنوع الفيروســات وتعـــددهــا، على المرء أن يبدأ بأساسيات ما يتصل بماهيتها وما لا يتصل. من السهل الحديث عمّا لا يتصل بماهيتها. فهي ليست خلايا حية، لأن الخلية -من النوع الذي يتجمع بعدد كبير ليكوّن الجسم البشري أو جسم الأخطبوط أو زهرة الربيع- تحتوي على آليات معقدة لبناء البروتينات، وتعبئة الطاقة، وأداء وظائف أخرى متخصصة؛ وذلك تبَعًا لِما إذا كانت تلك الخليةُ خليةً عضلية أو خلية نسيج خشبي أو خلية عصبية. والبكتيريا هي أيضًا خلية لها سمات مماثلة، وإن كانت بنيتها أبسط بكثير. أما الفيروس فلا تجمعه أي قواسم مشتركة بما سبق. أما تحديد ماهية الفيروس فقد ظل أمرًا بالغ التعقيد إلى درجة أن التعريفات تغيرت على مدى ما يقرب من 120 عامًا. ففي عام 1898، افترض "مارتينوس بيجيرينك"، عالم النبات الهولندي الذي درس فيروس تبرقش التبغ، أنه سائل مُعدٍ. وظل تعريف الفيروس فترة من الزمن يتحدد أساسًا بالنظر إلى حجمه؛ كالقول إنه شيء أصغر بكثير من البكتيريا ولكنه -مثل البكتيريا- يمكن أن يسبب المرض. وفي زمن لاحق، كان يُعتقد أن الفيروس عامل لا يمكن رؤيته بالمجهر العادي، ولا يحمل سوى جينوم صغير للغاية، ويتكاثر داخل الخلايا الحية. لكن ذلك لم يكن سوى خطوة أولى نحو فهم أوسع لماهية الفيروس. وكتب عالم الأحياء الدقيقة، الفرنسي "أندريه لووف"، في مقالة مؤثرة نُشرت عام 1957 بعنوان "مفهوم الفيروس": "سأدافع عن وجهة نظر متناقضة، وهي أن الفيروسات فيروسات". لم يكن ذلك تعريفًا مفيدًا بقدر ما كان تنبيهًا معقولا؛ أو طريقة أخرى للقول إنها "فريدة من نوعها". والحال أن الرجل إنما كان بقوله ذاك يهيئ الجمهور لحقائق أعمق وأعقد. كان لووف يعرف أن توصيف الفيروسات أيسر من تعريفها. فكل جُسيم فيروسي يتكون من مجموعة من التعليمات الوراثية (مكتوبة إما في الحمض النووي، "DNA" أو في ذلك الجزيء الآخر الحامل للمعلومات، أي الحمض النووي الريبوزي، "RNA") المعبأة داخل قشرة بروتينية (تُعرف باسم القفيصة، "capsid"). وفي بعض الحالات، تكون القفيصة محاطة بغلاف غشائي يحميها ويساعدها على الالتصاق بإحدى الخلايا. ولا يمكن للفيروس أن يستنسخ نفسه إلا بدخوله خليةً والاستيلاء على "آلة الطباعة ثلاثية الأبعاد" (يُقصَد الخلايا الريبية) التي تحوّل المعلومات الوراثية إلى بروتينات.
إذا كانت الخلية المضَيِّفة سيئة الحظ، يتشكل فيها العديد من الجسيمات الفيروسية الجديدة؛ فتظهر هذه الأخيرة وتنتشر بسرعة كبيرة وتترك الخلية كالحطام. وهذا النوع من الضرر (وهو مثل الضرر الذي يسببه فيروس "سارس-كوف2-" في الخلايا الظهارية التي تبطن القناة التنفسية البشرية) هو تجسيد جزئي للطريقة التي يصبح بها الفيروس مسببًا للأمراض. ولكن إذا كانت الخلية المضيِّفة محظوظة، فإن الفيروس قد لا يتعدى الاستقرار في موقعه المريح الدافئ هذا (فإما يغط في سبات عميق وإما ينكب على تناسخ عكسي "Retroviral Replication" لجينومه الصغير داخل جينوم المضيّف) متحينًا فرصًا مناسبة. وينطوي هذا الاحتمال الثاني على تداعيات عديدة تتصل باختلاط الجينومات، والتطور، وحتى بشعورنا بهويتنا البشرية، وهو موضوع سأعود إليه لاحقًا؛ لكن سأكتفي الآن بإشارة واحدة إليه: فلقد أكد عالم الأحياء البريطاني "بيتر ميداوار" وزوجته الكاتبة "جين" في كتاب شهير صدر لهما عام 1983، أنه "لا يُعرف عن أي فيروس أنه يقوم بعمل حسن: فقد حسُن قول القائل إن الفيروس 'نبأ سيء مغلف بالبروتين'". والحال أنهما جانَبا الصوابَ في ذلك. وكذلك أخطأ كثير من العلماء حينها، ولا يزال هذا الرأي يحظى بالقبول لدى كل شخص تقتصر معرفته بالفيروسات على الأنباء السيئة، من قبيل الإنفلونزا و"كوفيد19-". لكن أضحى من المعروف اليوم أن بعض الفيروسات يقوم بعمل حسن. فما يُغلّفه البروتين هو رسالة وراثية (جينية)، وقد تحمل خبرا سارًا أو نبأ سيئًا، حسب الأحوال.
لكن.. من أين أتت أولى الفيروسات؟ يقول العلماء إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي الرجوع بالزمن إلى ما يقرب من أربعة مليارات سنة، إلى عصر كانت فيه الحياة على الأرض قد انبثقت لتوّها من طهي غير مكتمل للجزيئات الطويلة والمركبات العضوية البسيطة والطاقة. ولنَقُل إن بعضًا من تلك الجزيئات الطويلة (ربما الحمض النووي الريبوزي) بدأ عملية استنساخ. هنالك عند هذه النقطة يكون الانتقاء الطبيعي الذي تحدث عنه "داروين" قد بدأ، مع تكاثر تلك الجزيئات (وهي الجينومات الأولى) وتحورها وتطورها. ولعل بعضها، وهو يتلمس طريقه من أجل نيل ميزة تنافسية، قد وجد الحماية أو أوجدها داخل الأغشية والجدران؛ مما أفضى إلى الخلايا الأولى. ونشأت من هذه الخلايا سلالةٌ أخرى من خلال الانشطار، بالانقسام إلى قسمين. وقد انقسمت بمعنى أوسع أيضًا، إذ تفرعت لتتشكل منها البكتيريا والعتائق (Archaea)، وهما نطاقان من نطاقات الحياة الخلوية الثلاثة. أما النطاق الثالث، وهو حقيقيات النوى (Eukarya)، فقد نشأ في وقت لاحق؛ ويشمل البشر وجميع الكائنات الأخرى (الحيوانات والنباتات والفطريات وبعض الجراثيم) المكونة من خلايا ذات تشريح داخلي معقد. وهذه هي الفروع الثلاثة الكبرى لشجرة الحياة بصيغتها الحالية.
لكن ما موقع الفيروسات؟ وهل هي فرع رئيس رابع أم إنها نوع من الهدال (Mistletoe)، أي طفيلي أتى من مكان آخر غير شجرة الحياة تلك؟ تضرب معظم نماذج هذه الشجرة صفحًا عن الفيروسات فتُسقطها من فروعها. وتؤكد إحدى المدارس الفكرية أنه ينبغي عدم تضمين الفيروسات في شجرة التطور، لأنها ليست حية. وتلك حجة معلَّقَة، إذ تتوقف على تعريف كلمة "حية". أما الأمر الأكثر إثارة للفضول فهو منح الفيروسات موقعًا داخل الخيمة الكبيرة المسماة بالحياة، ومن ثم التساؤل عن كيفية دخولها. ثمة ثلاث فرضيات رئيسة تفسر الأصولَ التطورية للفيروسات، وتُعرَف لدى العلماء بفرضية الفيروسات أولا، وفرضية الهروب، وفرضية الاختزال. تُفيد الفرضية الأولى أن الفيروسات ظهرت إلى الوجود قبل الخلايا، إذ عمدت -بطريقة ما- إلى تجميع نفسها مباشرة من ذلك "المطبخ" البدائي. أما الثانية فتشير إلى أن المورّثات أو امتدادات الجينومات تسربت من الخلايا، وأصبحت مغلفة داخل القفيصات البروتينية؛ ثم تمردت إذ وجدت لنفسها موضعًا جديدًا بصفتها طفيليات. أما فرضية الاختزال فتشير إلى أن الفيروسات نشأت عندما تقلص حجم بعض الخلايا بفعل ضغوط تنافسية (إذ يسهل الاستنساخ والتكاثر كلما كان الحجم صغيرًا وبسيطًا)، طارحةً المورّثات إلى أن اختُزلت إلى الحد الأدنى الذي لا يمكنها من البقاء على قيد الحياة إلا من خلال التطفل على الخلايا.
وثمة متغير رابع يُعرف باسم الفرضية الكيميرية، التي تستلهم أساسَها من فئة أخرى من العناصر الوراثية، ألا وهي النقلونات (Transposons، وتسمى أحيانًا المورّثات القافزة). فقد استدلت عالمة الوراثة "باربرا ماك لينتوك" على وجود النقلونات في عام 1948، وهو الاكتشاف الذي نالت عنه جائزة نوبل. وتحقق هذه العناصر الانتهازية نجاحها وفق المفهوم الدارويني عن طريق الانتقال من جزء من الجينوم إلى آخر، وفي حالات نادرة من خلية إلى أخرى، بل حتى من نوع إلى آخر، باستخدام الموارد الخلوية لاستنساخ نفسها على نحو متكرر. ويُسهم الاستنساخ الذاتي في حمايتها ضد الانقراض العرَضي؛ إذ تتراكم بطريقة غريبة وغير مألوفة. فهي تشكل، على سبيل المثال، ما يقرب من نصف الجينوم البشري. وربما نشأت أولى الفيروسات، تبعًا لهذه الفكرة، من هذه العناصر باستعارة البروتينات من الخلايا التماسًا منها للحماية داخل قفيصات واقية؛ وهي استراتيجية على جانب كبير من التعقيد. لكل فرضية من هذه الفرضيات أسس موضوعية. لكن في عام 2003، رجح دليل جديد كفة فرضية الاختزال لدى الخبراء: إنه الفيروس العملاق.