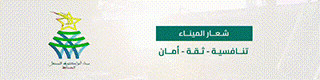في انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجري كل أربع سنوات، تتخذ مفاهيم الربح والفوز والنصر والخسارة دلالات مختلفة عما تنطوي عليه عموماً هذه المفردات، فالخاسرون اليوم هم من ربحوا العام 2016، وقد أثبت تاريخ هذه الانتخابات أنهم من بعد خسارتهم سيربحون مجدداً، في غضون بضع سنين، لأن الصراع الحقيقي على البيت الأبيض لا يُختزل في منافسة شخصين، كبايدن وترامب، بل هو التسابق المحموم بين الحزبين اللذين يتبادلان السيطرة على الرئاسة الأميركية ومؤسساتها الدستورية الأخرى منذ مئات السنين، الجمهوري والديموقراطي.
كان فوز ترامب، القادم من عالم المال في أوضح نماذجه الأميركية، حدثاً سياسياً فريداً كسر كل توقعات المحللين ومتتبعي استطلاعات الرأي وكل أنواع التقصي الأخرى، حتى الذين توقعوا فوزه أقرّوا، بشكل أو بآخر، أنهم فوجئوا كغيرهم، وأن تنبؤهم لم يكن مبنياً على استنتاجات منطقية بقدر ما كان مزيجاً من التخيلات أو الأمنيات من قبيل "رُبّ رمية من غير رامٍ". فقد كان ترامب، سيد البيت الأبيض الجديد، وقتذاك، بعيداً بشخصيته وسماته، وحتى بسلوكه، عن شخصية الرئيس النمطية في واشنطن. فهو رجل تلاحقه المشكلات والإشاعات والتصريحات الغريبة حيث حلّ، صريح أحياناً حدّ الإحراج، ارتجالي لا يعتمد النصوص التي أعدت سلفاً، شعبوي لافت للأنظار في زمن ظن الجميع فيه أن صفحة الشعبوية قد طُويت نهائياً في الثقافة الأميركية المعاصرة.
بعد فوزه المفاجئ قبل أربع سنوات، استطاع المحللون التقاط أنفاسهم سريعاً وإعادة ترتيب أوراقهم ليجدوا ألف سبب وسبب لتفسير ما حصل. كان اللافت بين هذه الأسباب كلها أن معركة الانتخابات التقليدية لم تدُرْ بين الديموقراطيين والجمهوريين، بل بين المرشحين نفسيهما، هيلاري كلينتون التي طمحت لتكون أول رئيسة للولايات المتحدة ودونالد ترامب النموذج التقليدي المرغوب للناخبين الذين لم يكونوا مستعدين لمنح أصواتهم لامرأة. لذلك قيل وقتها، على سبيل الفكاهة، أن ترشح كلينتون شخصياً كان أهم أسباب صعود ترامب الذي استأثر بأصوات أنصار الجمهوريين وأصوات مؤيدي الذكورية.
تغيّر الأمر تماماً في الأسبوع المنصرم، إذ كانت أغلب الدلائل والتحليلات تشير إلى خسارة ترامب، وكان هذا هو الرأي السائد حتى في أضيق الدوائر الجمهورية، كما أن مناقشات شبه جادة طفت على السطح في ما يتعلق بتعنته ورفضه الاعتراف بالخسارة والسيناريوهات المحتملة جراء ذلك. ومع هذا خاض الحزبان الجمهوري والديموقراطي انتخابات طبيعية بالنسبة لمجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، وجاءت نتائجها (حتى الآن) متوقعة إلى حد ما. وقد يعني هذا تماماً أن عدم التصويت لترامب ارتبط بشكل مباشر بشخصه، وليس بسياسات الجمهوريين في الولايات المتحدة. بعبارات أخرى، ليس من المبالغة في شيء القول إن كثيرين لم يصوتوا لبايدن. هم فقط صوّتوا ضد ترامب نفسه، في سيناريو شبيه ربما بما حصل المرة الماضية عندما صوّت كثيرون ضد كلينتون فأوصلوا ترامب إلى المكتب البيضاوي.
والواقع أن أغلب تحليلات النتائج تأخذ شكلاً انفعالياً في تناول خسارة ترامب، خصوصاً تلك التي تصدر خارج الولايات المتحدة. فهناك معلقون اعتبروا الحدث في حد ذاته انتصاراً كبيراً للديموقراطية، وهذا أمر بالغ الغرابة، فالديموقراطية ذاتها هي التي أتت به رئيساً قبل أربع سنوات؛ فيما رأى آخرون أن فوز بايدن هو انتصار للقيم الإنسانية، وهذا أمر أشد غرابة من الأول، إذ استطاع ترامب، رغم خسارته، حصد الملايين من أصوات الناخبين الأميركيين، وتمكن من تثبيت شعبية شخصيته ذات السمات غير المعهودة في الإدارات الأميركية منذ عقود.
وباعتقادي لا ينبغي أن تنحرف النظرة الموضوعية لما حدث إلى مسارات قيمية وأخلاقية مبالغ بها في عالم السياسة. ولا شك أن بعض من صوتوا ضد ترامب، وبعض المؤثرين في الرأي العام ممن عارضوه أيضاً، قرروا ذلك بناء على تقييمهم الذاتي لشخصه. لن يقلل هذا بأي حال من الكاريزما التي تمتع بها الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأميركية، والتي أهلته ليكون سيد البيت الأبيض لأربع سنوات. غير أنه لا يمكن، في المقابل، إنكار حدّة الظروف الموضوعية التي حاربته حرباً شعواء، وكان على رأسها ملف وباء كورونا الذي كان لأميركا النصيب الأكبر من تبعاته السلبية، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي.
ينبغي من جهة ثانية تفهُّم الأثر العميق للانتخابات الأميركية على السياسة العالمية والعلاقات الدولية، فالولايات المتحدة ما زالت القوة السياسية والعسكرية الأولى عالمياً، ولا شك أن تغيير الرئيس سيفرض إجراء تبديلات جذرية في الإدارات والموظفين والتوجهات التي تخص الملف الخارجي برمته. ورغم النشاط الخارجي الأميركي الذي تحقق في السنوات الأربع الماضية، إلا أنه من المتعارف عليه أن ينصبّ التركيز في الولاية الأولى لسيد البيت الأبيض، أياً كان، على الشأن الداخلي لضمان إعادة انتخابه، فإذا فاز بالولاية الثانية استطاع التفرغ أكثر للسياسة الخارجية لأنه لا يعود محكوماً بالحاجة لاسترضاء الناخبين مرة ثانية.
بناء عليه، فإن ضياع الولاية الثانية بالنسبة لترامب ربما سيضع ما أنجزته بلاده على المستوى الخارجي في مهب الريح، خاصة في ملفات شائكة وشديدة التعقيد، كالملف الإيراني وملف السلام العربي الإسرائيلي. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة، والأقطاب السياسية الإقليمية، لاسيما في المنطقة العربية، ستحافظ على تركة ترامب وعلى المكتسبات المهمة التي تحققت خلال ولايته؟ أعتقد بأن الإجابة الجيدة على هذا السؤال مشروطة بوضع خطط عمل بديلة تتسم بالمرونة والسرعة، خصوصاً في الوقت "الرئاسي" بدل الضائع منذ الآن وحتى كانون الثاني (يناير) المقبل.
أخيراً... ليس مهماً أن نكون قد أحببنا ترامب أم لم نحبه، بل المهم أن يكون رأينا فيه موضوعياً وصحيحاً. ولا شك أن خروجه من البيت الأبيض على عجل لن يكون أمراً عادياً، فقد كانت سنواته الأربع حافلة بالكثير من الأحداث، أثبت خلالها الأهمية الاستثنائية لمنصب الرئيس الأميركي، وأسقط وهماً سائداً كان يتعلق بأن إدارة السلطة وسياستها في الولايات المتحدة ثابتة وواحدة، بغض النظر عن توجهات الرئيس ومواقفه الشخصية وخصوصية تعامله مع الشأن السياسي. لقد استطاع ترامب، بشهادة معارضيه وأنصاره، أن يتجاوز دور ما يسمى بـ "الدولة العميقة"، فهل خسر الانتخابات لهذا السبب؟
ترامب الذي قضى على البغدادي، وسليماني، ولجم الاندفاع الإيراني، وواجه التنين الصيني، وقطع شوطاً متقدماً في ملف السلام العربي الأسرائيلي... إلخ، كأن يأمل أن تثمر إنجازاته السياسية بعدما أزهرت، غير أن الثمر الحقيقي كان هذه المرة في الديموقراطية الأميركية التي ما زالت مثالاً يحتذى لأحد أهم أشكال الحكم في العالم.
الكلمات الدالة