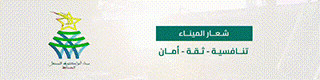شاركت على مدى يومين في ورشة حوار أقيمت في (جبيل) بلبنان بعنوان (جدل المواطنة والانتماء الطائفي: وثيقة الوفاق الوطني اللبناني- نموذجاً) برعاية المركز الدولي لعلوم الإنسان التابع لمنظمة اليونسكو…
ناقش المشاركون تكوين لبنان الطائفي، وصيغة الولاء له، وكذلك اتفاق الطائف في ميزان النقد: ما تحقق منه، وما لم يتحقق؟؟ والمسكوت عنه في اتفاق الطائف: محاسبة مواطنية، إضافة إلى المحور الذي شاركت به وهو الواقع الطائفي، والمواطني في لبنان والبلاد العربية مقاربة من موقع المقارنة (العراق، وسورية، والأردن).. أصدقكم القول إنني لمست عمق الأنين، والألم، والمعاناة التي يعيشها اللبنانيون، ومعهم العراقيون من فظاعة النظام الطائفي الذي يتغلغل في شرايين كل مواطن في البلدين، إذ أشار المشاركون اللبنانيون إلى أن اللبناني تتنازعه ثلاثة ولاءات: (الولاء للطائف، والولاء للوطن، والولاء للخارج) وفي ظل تعدد الولاءات تساءل البعض: هل يمكن بناء مواطنية وولاء للموطن!! وفي ضوء النقاشات التي جرت ليومين بدا الجميع شبه يائس من إمكانية انتقال لبنان إلى المواطنة التي تحتاج إلى التركيز على عنصر الانتماء للدولة والوطن بدلاً من الانتماءات الفرعية، وجرى الحديث عن حقوق المواطنة (المدنية السياسية، الاقتصادية، القانونية، العيش المشترك…إلخ) وواجبات الدولة (العمل- الاقتصاد- التربية- الأمن… إلخ)،
ولكن العقبات تبدو في زعماء الطوائف، وفي التداخل في الدستور بين المواطنة، والطائفية، مشيرين إلى أن أهم البنود الإصلاحية في الطائف لم يطبق منها أي شيء، وهي:
– إلغاء الطائفية السياسية.
– التنمية المتوازنة (بما يعزز المواطنة).
– اللا مركزية الإدارية الموسعة في إطار وحدة الدولة.
– قانون انتخاب جديد يعزز المساواة، ويؤمن صحة التمثيل السياسي للجميع، ويضمن العيش المشترك.
– السلطة القضائية المستقلة، والمجلس الدستوري ودوره.
وبرأي النائب السابق نجاح واكيم فإن أخطر ما طبق هو المزج بين ميليشيات السلاح، وميليشيات المال، وأن لبنان شركة مساهمة، وليس دولة، ويعيش حالياً على الإنعاش: ممنوع أن يموت، وممنوع أن يعيش؟ ورئاسة الجمهورية، والحكومة حالياً مجرد (حقن) إنعاش ليس إلا!
لكنه يرى كالكثيرين أن الإصلاحات لا تتحقق إلا بالقوى العابرة للطوائف، وأن الدواء المطلوب للشفاء يجب أن يصنعه اللبنانيون بأنفسهم، فإذا نجحوا فسوف ينجون، وإذا فشلوا سيبقون بلا وطن؟
ووفقاً لما أجمع عليه المشاركون اللبنانيون فإن النظام الطائفي جرب وانتهى مفعوله، ولذلك لا بد من الحديث عن المواطنة، وعن قانون انتخاب جديد يكون لبنان فيه صاحب رسالة، ويعمل القانون على الدمج بين أبناء المجتمع على قضايا محددة، لأن القتل على الهوية الذي عاشه اللبنانيون أبان الحرب الأهلية ليس رسالة، وممارسات زعماء الطوائف، وتقسيم الناس، وتحويلهم لرعايا تحت سلطة زعيم كل طائفة ليس رسالة، بل تعبير عن إقطاع سياسي! أما العراق الذي أدماه الاحتلال، وصمم له دستوره، ونظامه الطائفي- المذهبي- الاثني، فإن واقعه حسب المفكر العراقي الصديق، د. عبد الحسين شعبان يوصلك إلى علاقات فارقة منها:
– انتقال العراق من الحكم المركزي الشديد الصرامة إلى حالة من الفوضى أقرب إلى اللا دولة.
– انبعاث الهويات الفرعية بسبب إضعاف الاحتلال الأميركي للدولة العراقية، وغياب السلطة المركزية، مع شعور مزمن بالإقصاء والتهميش من فئات عراقية.
– انتقال العراق من الدكتاتورية الأحادية إلى دولة المحاصصة الطائفية، الاثنية- الغنائمية ذات المراكز المتعددة.
– انتقال العراق من نظام الحزب الواحد، إلى فوضى الأحزاب.
– انتقال العراق من بلد مستقل إلى تآكل الاستقلال الوطني، وضعف السيادة.
– انتقال العراق من وجود جيش وطني، إلى جيش يفتقد إلى عقيدة عسكرية متينة بسبب انضمام ميليشيات تابعة لأحزاب، وقوى معارضة وفقاً للتقاسم الوظيفي الاثني، والمذهبي.
– انتقال العراق من احتكار السلاح إلى انفلات السلاح.
– انتقال العراق من الفساد الذي كان محدوداً، وغير ظاهر، إلى فساد منفلت من عقاله، حيث أشار د. عبد الحسين شعبان إلى أنه منذ تسلم بول بريمر إلى الآن بدّد الحكام الجدد في العراق حوالى (ألف) مليار دولار أي تريليون دولار ضاعت هباءً منثوراً دون إنجازات تذكر.
– وانطلاقاً من الصورتين اللبنانية، والعراقية اللتين كانتا نتاج ماض استعماري عثماني- فرنسي في حالة لبنان، وأميركي حديث في حالة العراق، فإن الحالة السورية، وما تتحمله سورية شعباً، وقيادة من ضغوط هائلة هدفها منع أي شكل من أشكال اللبننة- أو العرقنة، وهي وصفات جاء بها موفدون دوليون كثر منهم (الأخضر الإبراهيمي) الذي شارك بنفسه في إنجاز اتفاق الطائف، وسوق لما سمّاه طائفاً سورياً رفض بالمطلق، وجرى ترحيله إلى مزبلة التاريخ بدماء أبناء الشعب السوري، وجيشه البطل.
إن قراءة سريعة لدساتير سورية منذ أيام الملكية في عشرينيات القرن الماضي، حتى دستور عام 2012 توصلنا إلى أن سورية لم تعرف في تاريخها اتجاهاً لفرز أفكار طائفية، أو دسترتها، ذلك أن التركيز كان يتم على المواطنة، والحقوق الأساسية، ويظهر ذلك في مؤسسات الدولة السورية: الجيش، التعليم، وغيرهما الكثير. وإذا كنت قد قدمت رؤية سورية لماضيها، وحاضرها، ومستقبلها خلال أعمال هذه الورشة، ورفض السوريين للاتجاهات المذهبية والطائفية، فإنه يبدو لي من خلال النقاشات التي جرت أننا نحن السوريين أمام امتحان تاريخي كبير، فإما أن ننجح به ونقدم نموذجاً في المنطقة يشكل قاطرة لسحبها اتجاه دول مدنية تعزز المواطنة، والانتماء العربي، وتخدم قضايا الشعوب الأساسية، أو أن المنطقة ستذهب باتجاه عصر انحطاط كامل.
قناعتي أن السوريين الذين واجهوا هذه الحرب الإرهابية- الفاشية وقدموا خلالها نموذجاً نادراً في الصمود الأسطوري، وتحملوا ما لا يتحمله بشر، لن يسمحوا لأحد أن ينتزع منهم بالسياسة، ما فشل في تحقيقه بالإرهاب، والقتل، والتدمير، والتحدي هنا يبرز من خلال إنتاج دستور عصري متنور لسورية المستقبل يحافظ على وحدتها، ويعزز استقلالها، وقرارها الوطني ويقوي مؤسسات الدولة، ويمنح حريات سياسية، وغيرها من الحريات تحت سقف القانون، وبناء على ذلك، وما تتطلبه هذه المرحلة من قانون أحزاب، وقانون انتخابات، فإن أمل المنطقة في سورية التي حافظ جيشها على وحدة البلاد، وقدم نموذجاً للجيش العقائدي، وعلى تعزيز القيم العروبية، والوطنية، وكَِنْسِ كل بصمات المشروع الوهابي- التكفيري ليس فقط على الأرض، إنما من عقول آلاف السوريين الذين غُسلت أدمغتهم بآلة جهنمية من وسائل الإعلام، ومشايخ الفتنة، والبترودولار. لا أبالغ إذا قلت إن المشروع السوري- التنويري هو أمل للمنطقة، وشعوبها، وهذا المشروع بالتأكيد يواجه تحديات حقيقية، ومخاطر جدية، ولكن أولئك الذين كانوا يعدون الأيام، والأشهر، والسنوات لإسقاط سورية، ها هم يسقطون الواحد تلو الآخر، لتبقى سورية أمل المنطقة، وشعوبها.