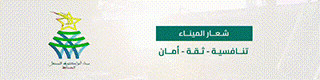إن معالجة الحليب صناعيًا تهدف أساسًا إلى رفع جودة الحليب والاستفادة قدر الإمكان من مختلف مكوناته لإنتاج مشتقات متعددة منه. كما تساهم هذه المعالجة في تحسين الجودة الميكروبيولوجية وتنقية الحليب من الشوائب الفيزيائية.
تمتلك الشركة معدات متطورة تمكنها من القيام بعمليات المعالجة لازمة قبل المعالجة الحرارية لتنقية الحليب والرفع من جودته . غير أن نجاح هذه العمليات يتوقف على وصول الحليب إلى المصنع قبل فقدانه لخصائصه الفيزيائية، وهو أمر لا يتحقق إلا إذا تم:
جمع الحليب في ظروف نظيفة وسليمة.
نقله بسرعة وباستخدام تقنيات توفر درجات حرارة مناسبة.
إيصاله إلى سلسلة التبريد في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات من عملية الحلب.
في حال عدم توفر هذه الشروط، يصبح الحليب معرضًا للتلف والفساد، وهو ما قد لا يلاحظه المنمي مباشرة، لكنه يمنع إمكانية معالجته داخل المصنع. ومن أهم المعايير التي يعتمد عليها لتحديد فقدان الحليب لخصائصه الطبيعية قياس درجة الحموضة.
أهمية قياس حموضة الحليب
يُعد تقدير حموضة الحليب من أهم الاختبارات لتحديد جودته في المعامل، كما أنه يعكس حالة الأبقار في المراعي وظروف الإنتاج. ويساعد قياس الحموضة في الأمور التالية:
الكشف عن ظروف الإنتاج السيئة التي رافقت عملية الحلب، جمع الحليب، أو تخزينه.
تشخيص أولي لاحتمالية إصابة الأبقار بالتهاب الضرع.
تحديد ما إذا كان الحليب صالحًا للمعالجة أو مرفوضًا في معامل الألبان، حيث أن ارتفاع الحموضة يؤدي إلى تخثر الحليب عند تعريضه للحرارة، وبالتالي يوجه اختبار الحموضة الحليب إلى خط التصنيع المناسب.
تقييم الحليب صحيًا والتأكد من صلاحيته للاستهلاك.
أنواع الحموضة في الحليب
1- الحموضة الظاهرية:
الحليب الطازج يحتوي على نسبة طبيعية من الحموضة تتراوح بين 0.14% إلى 0.18%، ناتجة عن مكونات الحليب الأساسية.
نسبة حمض اللاكتيك في الحليب الطازج تكون أقل من 0.002%.
2- الحموضة الحقيقية:
تنتج عن:
سوء إنتاج الحليب مما يؤدي إلى زيادة التلوث بالأحياء الدقيقة.
سوء التخزين أو عدم التبريد، مما يوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.
تؤدي هذه العوامل إلى تخمير سكر الحليب (اللاكتوز) إلى حمض اللاكتيك بفعل بكتيريا اللاكتيك، وهو ما يرفع من درجة حموضة الحليب.
المهندس احمد سالم محفوظ