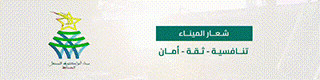عرفت مختلف المناطق الموريتانية في القرنين الـ18 والـ19 نهضة ثقافية عربية إسلامية جعلت منها منارةً ثقافية لم يقتصر إشعاعها على جزء هام من أفريقيا الغربية، وإنما شمل كذلك المغرب والمشرق العربيين. فقد درّس بعض الأساتذة الموريتانيين الأجلاء في الجامع الأزهر بالقاهرة، والذي يعد أعرق جامعة عربية إسلامية وأبرزها. وعُرف أولئك العلماء بالشناقطة نسبةً لمدينة شنقيطي الآدرارية، وهي تسمية أطلقها إخوتنا المشارقة على بلادنا قبل استقلالها تحت اسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية. واشتهر علماء موريتانيون آخرون في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأردن والسودان وتركيا وغيرها. وفى موريتانيا نفسها، وفي منطقة النهر بوجه خاص، عرفت تلك النهضة الثقافية أسطع تجسيد لها في ميلاد الدولة المامية في فوته. وتتالى على رأس هذه الدولة أربعة وخمسون «مامياً» (إماماً). وكان يشترط في المامي أن يكون أعرف هيئة الناخبين المؤلفة أساساً من العلماء بالمعارف الإسلامية وباللغة العربية. ومعنى ذلك أن اللغة العربية كانت، قبل وجود اللغة الفرنسية، لغة التواصل المكتوبة الوحيدة لا في بلادنا فحسب، وإنما كذلك في شبه منطقتنا بل وبالنسبة للجزء الأكبر من قارتنا. وخاضت جمهورية فوتة التيوقراطية مقاومة عنيدة وبطولية ضد التغلغل الفرنسي. وكثيراً ما استنجد الأئمة الفوتيون بحلفائهم البيضان فى إمارتي الترارزة والبراكنة وغيرهما خلال حروبهم مع الغازي الفرنسي. وانتصر الفرنسيون في الأخير وحطموا نهائياً إمامة فوته. وعليه، فإن المراسلات في شمال موريتانيا وفي جنوبها كانت تتم إلى وقت قريب باللغة العربية فقط، سواء أكان ذلك بين الخواص أو بين الزعماء والمجموعات أو بين الزعماء ورعاياهم.. إلخ. وكان يُسعى إلى معرفة اللغة العربية سعياً في أعماق البلاد، سواء على مستوى المزارعين المستقرين في الجنوب أو على مستوى المنمين البداة في باقي موريتانيا. فالعارفون باللغة العربية في ضفة النهر وفي غيرها من مناطق البلاد كانت لهم منزلة اجتماعية متميزة -وما تزال- حتى ولو لم تكن لهم وظيفة محددة من تعليم وكتابة وقضاء وإصلاح ذات بين وإمامة مسجد مدينة أو قرية وغيرها. وبوسع الشخص الواحد أن يقوم بمختلف هذه الوظائف. وما ذا نقول عن مكانة الزعماء الدينيين ونفوذهم الكبير المرهون بمعرفتهم اللغةَ العربية التي تمكّنهم -وحدها- من معرفة القرآن والسنّة وغيرهما من النصوص الشرعية؟
أما في موريتانيا الناطقة بالحسانية، فإن العارفين فيها كانوا يتلقون معارفهم في المحاضر وما زالوا إلى اليوم وإن كان بأعداد أقل شيئاً فشيئاً. وتعتبر هذه الجامعات البدوية المتنقلة من خصوصيات بلادنا والمناطق المماثلة لها في الصحراء الغربية كأزواد في شمال جمهورية مالي الحالية، ولا نجد لها مثيلا في بقية العالم. وكانت توجد في ضفة النهر وما تزال -ولو بعدد أقل شيئاً فشيئاً- مدارس عربية تلائم المستقرين، كانت وما تزال تكوّن إطارات ناطقين بالعربية.
وبعد احتلال البلاد، انتهجت الإدارة الفرنسية إزاء تعليم اللغة العربية موقفين مختلفين في جنوب البلاد وشمالها. ففي حين أخذت هذه الإدارة موقفاً متسامحاً، بل ومشجِّعاً إلى حد ما، للغة العربية (إنشاء المدارس المزدوجة) في الشمال، حاربتها في الجنوب وأحلت محلها تدريجياً اللغة الفرنسية. غير أن ذلك اقتصر أساساً على المراكز القروية الكبرى، وقد ناهضته الأوساط الدينية وبعض سكان المدن. وعليه، فإنه إذا كان قد تم فتح مدارس ابتدائية مبكراً في بعض مدن الضفة -كانت أولى تلك المدارس قد فُتحت في كيهدي سنة 1905- فإن معظم الأسر هناك قد عارضتها من منطلق أنها لا تريد إرسال أبنائها إلى «مدرسة الكفار»، شأنها في ذلك شأن المناطق الناطقة بالحسانية وموقفها من أولى المدارس التي فُتحت فيها. وقد لجأت الإدارة الفرنسية، في هذه الحال كذلك، إلى استخدام القوة أحياناً لفرض تعليم لغتها. وعلى الرغم مما استخدمته الإدارة من وسائل، فإن سكان إحدى قرى كوركول قد استمروا في رفضهم البات إرسالَ أبنائهم إلى «مدارس الكفار» حتى استقلال البلاد. وبالمقابل، ظلت المدارس القرآنية قائمةً في معظم قرى وادي النهر -إن لم نقل فيها كلها- كما في الأحياء البدوية البيضانية، وما تزال موجودة إلى اليوم وإن قلّ روادها. وظلت المراسلات بالبولارية والصوننكية والولفية في هذه المنطقة تكتب باللغة العربية.
وعليه، فإن عداء الأطر الجنوبيين الناطقين بالفرنسية لتعليم اللغة العربية لا تشاطرهم إياه، البتةَ الأغلبيةُ الساحقةُ من السكان الذين ظلوا شديدي التعلق باللغة العربية بوصفها لغة القرآن. ولهذا السبب، فإنني على ثقة من أنه لو نُظم استفتاء شعبي حول هذه المسألة في وادي النهر، فإن الأغلبية الساحقة ستصوت لصالح هذا التعليم.
ورأيي أن لهذا العداء سببين رئيسيين، أحدهما مصرح به وذو بعد ثقافي. فهؤلاء المواطنون المتفرنسون المنحدرون من الجنوب يؤكدون أنهم لا يريدون أن يتعرّبوا مخافةَ أن يدمجوا ثقافياً من قبل مواطنيهم الناطقين بالحسانية. ولم يكن هذا السبب المصرح به دوماً أهم الأسباب بالنسبة للقائلين به. أما السبب الرئيس في نظري فهو ذو بعد اقتصادي واجتماعي، وإن لم يطرحه المعنيون من هذه الزاوية. فتأخر التمدرس باللغة الفرنسية في موريتانيا الناطقة بالحسانية مقارنةً بمنطقة النهر خلال العهد الاستعماري، جعل الإدارة الفرنسية مجبرةً على اكتتاب معظم موظفيها ووكلائها المحليين من الجنوب
الموريتاني الذي لم يكن مع ذلك يوفر لها كل حاجياتها. ولذا كانت تكمل اكتتابها من السنغال والسودان (مالي) والداهومي (بنين) وغيرها. وكانت النتيجة إبان الاستقلال أن معظم الوكلاء الموريتانيين في الإدارة ينحدرون من جنوب البلاد، بينما ارتفعت نسبة تمدرس الناطقين بالحسانية بشكل ملحوظ بعد ذلك وأصبحوا ينافسون مواطنيهم من أهل الجنوب في الإدارة التي تمثل وقتها أهم سوق للعمل في البلاد. ومن هنا كانت مخاوف هؤلاء من أن يفقدوا في النهاية مصدر رزقهم المتمثل في مناصب الوظيفة العمومية. وبغض النظر عن مردود تلك الوظائف المالي، فقد كانت -وما تزال- تمنح أصحابها منزلةً اجتماعية مرغوباً فيها، وتمثل قنطرةً للعمل السياسي. وكان لهذه المخاوف ما يسوِّغها إلى حد ما، خاصة وأن موريتانيا المستقلة كان عليها بالضرورة إعادة الاعتبار لتراثها الثقافي بإحياء موروثها العربي الإسلامي الذي عانى كثيراً من وطأة الاستعمار. كما عانى موروثها الأفريقي الصرف الذي يتعين إحياؤه كذلك.
وبما أن اللغة العربية التي هي أداة هذا الموروث الثقافي العربي الإسلامي، قد أهملت القوى الاستعماريةُ تدريسَها تدريجياً في المدارس حتى أصبح تعليمها اختيارياً في عهد القانون الإطاري بعد أن كان إجبارياً إلى جانب الفرنسية. وكان على سلطات الاسَتقلال أن تستأنف تدريس اللغة العربية وتطوره وتعممه. وهذا ما تطلب اكتتاب العديد من معلمي اللغة العربية عن طريق المسابقة غالباً. بيد أن العارفين باللغة العربية كانوا أكثر في المكونة الناطقة بالحسانية في البلد. ولذا كان البيضان يستحوذون على النصيب الأوفر من الوظائف الجديدة. ونجد الوضعية ذاتها في قطاع العدالة، وإن بأعداد من الوظائف أقل كثيراً.
ومن هنا كانت خشية الأطر الناطقين بالفرنسية المنحدرين من الجنوب من أن يكتسح البيضان الناطقون بالفرنسية أرضيتَهم الخاصة ما داموا حاصلين على نفس المؤهلات الفنية التي يتمتعون بها وآخذين في منافستهم بشكل جدي.
ولذا قلتُ إن مخاوف مواطنينا من أطر الجنوب مفهومة إلا أنها مع ذلك غير مبررة في نظري. فبغض النظر عن التقدم الحاصل في مجال التعريب، فإن تكوين الأطر الأكفاء الناطقين بالعربية كان يتطلب الكثير من الوقت. ثم إن هذا التكوين كان ينبغي القيام به بشكل مخطط وتدريجي. وقد كان على هذا التكوين الممتد على فترة طويلة نسبياً لا تلحق الضرر بأحد، أن يُمكن بشكل منهجي ومنصف من تعويض الأطر الناطقين فقط بالفرنسية، وهم كثر على مستوى البيضان كما هم لدى الزنوج الموريتانيين. أما تعريب الإدارة الموريتانية الشامل فقد كانت عوائقه الفنية صعبة التذليل، ولم يكن من العقلانية في شيء القيام به نظراً لازدواجية البلد العرقية ولموقع موريتانيا الجغرافي؛ فجيراننا المباشرون الذين تربطنا بهم علاقات كثيرة جداً، يومية ومتعددة الأوجه، أي السنغال ومالي، ناطقون بالفرنسية. والتواصل معهم ومع شبه المنطقة الأفريقية وجزء آخر من العالم، يجعل معرفة اللغة الفرنسية مسألة ضرورة وذات جدوى لا جدال فيهما. كما لا جدال في أنها لغة المستعمر التي تساهم في مسخ شخصيتنا الثقافية، إلا أنها مع ذلك تشكل ثراءً ثقافياً بالنسبة لنا.
لذا فإنه يتعين بالضرورة على أي نظام يقود موريتانيا، مهما كانت طبيعته، أن يوائم بين التجذر في الداخل الذي لا غنى عنه، وبين الانفتاح الضروري على العالم الخارجي الذي يلزمها التعاون معه. ومن هذا المنظور، فإن تعلم اللغة الفرنسية بوصفها لغة التواصل الكبرى المتاحة لنا، لا غنى لنا عنه إلى جانب اللغة العربية. وبذا تكون بلادنا دوماً بحاجة إلى خدمات كل مواطنيها الناطقين بالعربية والفرنسية والمزدوجين.
وعلى الصعيد الثقافي، فإننا نحن الموريتانيين محظوظون جداً بحكم وقوع بلادنا في تقاطع ثقافتين كبيرتين هما الثقافة العربية الإسلامية والزنجية الأفريقية، وقد سمحت لنا صروف الدهر بإضافة ثقافة ثالثة. غير أن هذا الوضع الثقافي يجعل من الطبيعي بل ومن الحتمي تعرّض هؤلاء وأولئك لمختلف أصناف التأثيرات، إلا أن مواطنينا من أطر الجنوب يتعرضون لتأثيرين سلبيين جداً تجاه الثقافة العربية الإسلامية وبالتالي تجاه تعليم اللغة العربية. فهناك أولا تأثير الجامعة الفرنسية التي تكوِّن منذ الخمسينيات إطارات عليا مَدّت البلد بعدد من قادته السياسيين والإداريين. وبالفعل فإن الإطارات المكوَّنة في الجامعات الفرنسية ما تزال تشكل الغالبية العظمى من إطاراتنا رغم انتهاجنا سياسةً واعيةً بتنويع مصادر تكوين إطاراتنا. ولذا ظلّت اللغة الفرنسية لغة العمل الأولى على مستوى الحكومة والإدارة الموريتانيتين. وعليه، فقد بقينا -بحكم الضرورة- نعاني من الهيمنة الثقافية الفرنسية، وبالتالي من جامعتها. فهذه الجامعة العريقة التي ما فتئت، منذ قرون خلت، تضطلع بدور ثقافي رئيس عبر العالم، قد ظل يجتاحها على الدوام تيار قوي شديد العداء للمسلمين والعرب. ولم ينس أصحاب هذا التيار فترةَ الحروب الصليبية، وهم يتنكرون تماماً لكل ما ورثته الحضارة الغربية عن الحضارة العربية الإسلامية. إن وجود هؤلاء على مفترق طرق حداثة غير مسبوقة، يجعلهم يتمكنون من نقل أفكارهم المعادية وغير المصرح بها إلى أتباعهم دون أن يشعر هؤلاء بذلك. وهكذا يصنعون وفق رؤاهم خصوماً ألداء للحضارة العربية الإسلامية. كما يتعرض هؤلاء المواطنون لتأثير نظرية «الزنوجية» التي أعتبرُها محل نقاش كبير، رغم ما يربطني بالرئيس سينغور من صداقة وتقدير قديمين خالصين.
ومهما يكن من أمر، فإني أعتقد، انطلاقاً من الأسباب المبسوطة أعلاه، أنه لا ينبغي لنا أن نشعر بأي نوع من مركب النقص تجاه اللغة الفرنسية على الرغم من كونها لغة هيمنة أجنبية. كما لا ينبغي أن نتصف بهذا الشعور بالنقص تجاه اللغة العربية. فكل منهما لغة حضارة عظيمة مما يجعل منهما بالتالي لغتي انفتاح. وكلاهما تسهل اندماجنا في العالمين الأفريقي والعربي الإسلامي اللذين ننتمي إليهما معاً. ويتألف هذا الأخير من مكونتيه المتكاملتين وهما العالم العربي المؤلف من 200 مليون ناطق بالعربية، والأمة الإسلامية المكونة من مليار نسمة موزع عبر القارات الخمس.
وينبغي في هذا المضمار التذكير بحقيقة تاريخية مفادها أن اللغة العربية هي بكل المعايير جزء من الموروث الثقافي المشترك لكل الموريتانيين، سوداً كانوا أم
بيضاً. فهي لغة ديننا الإسلامي الحنيف، كما كانت على مدى فترة طويلة لغة التواصل المكتوبة الأولى والوحيدة بين أسلافنا، وبينهم وبين العالم الخارجي طيلة قرون.
ومن جهة أخرى تنبغي الإشارة إلى أن تجربة تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية ما قبل يوليو 1978، قد أثبتت أن لدى الأطفال السود القابلية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم الناطقون بالحسانية على تعلم اللغة العربية الفصحى. وهكذا كان الأوائل في الترتيب في العديد من الفصول أطفالا ينحدرون من أُسر من الجنوب غير ناطقة بالحسانية. وبالطبع، فإن الأطفال «الناطقين بالحسانية» لديهم قابلية أكثر لنطق اللغة العربية بحكم محيطهم اللغوي الأسري، إلا أن هذه الميزة الصوتية الأكيدة لا تلعب دوراً حاسماً في تعلّم اللغة. فالأمر المهم في نظر المختصين هو ذكاء الأطفال وجديتهم في العمل بغض النظر عن أصلهم العرقي.
أما بخصوص لغاتنا الوطنية غير المكتوبة، من بولارية وصوننكية وولفية، فتشكل العنصر الآخر المكوِّن لموروثنا الثقافي الوطني وتربطنا بمجموعات ثقافية مجاورة نعيش وإياها يومياً في وئام وانسجام. وينبغي لنا أن نقوم بكتابتها أولا بهدف تعليمها ثانياً. ولذا، يتعين علينا انتهاج أحدث الطرق في هذا المضمار والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة المجاورة (السنغال، مالي، وغينيا)، كسباً للوقت والمال، تلك الدول التي حلّت جزئياً المشكلات الفنية التي تطرحها كتابة وتعليم هذه اللغات، مع مواصلة البحث في إمكانية كتابتها فنياً بأحرف عربية بوصفها الحل الأمثل لأكثر من داع.
وعندما نتمكن، ولو جزئياً، من تحقيق بعض الأهداف السالف ذكرها، يكون بوسع بلادنا أن تظل كما كانت على الدوام أرض تواصل ثقافي وبوتقةً تنصهر فيها ثقافاتنا الأصلية، بحيث يثري بعضُها البعضَ الآخر. ولا شك في أن هذا الوضع يطرح علينا مشاكل عويصة جداً، كثيرة ومتنوعة. غير أن المهمة نبيلة وتستحق أن نذلل كل الصعاب التي تعترض سبيل تحقيقها. وقد بدأها جيلُنا بوصفه جيلا انتقالياً يضطلع بمهمات صعبة ومضنية للغاية. ويتعين على الأجيال الموريتانية القادمة مواصلَتَها وتحقيقَها بشكل أفضل، علماً بأنه لن يكون بوسع هذه الأجيال أبداً إنجازها على الوجه الأكمل، إذ الكمال لله وحده. ففي مجال البناء الوطني لا وجود في الواقع لنظام جاهز. فالعملية لا تتوقف أبداً عند حدّ زمني معين، بل تندرج في صيرورة تاريخية لا متناهية يضيف فيها كل جيل لبِنتَه إلى صرح البناء الوطني دائم التشييد.
المختار ولد داداه/ «موريتانيا على درب التحديات»
عرض أقل