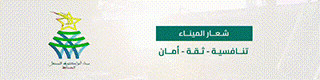لا يزال علماء الطبيعة يُراكمون التقارير الإحصائيّة حول التغيُّر المناخيّ، وانهيار التنوّع البيولوجيّ، وتردّي حالة المُحيطات، وتقلُّص مساحة الغابات، واضْطراب نِسَب تدفّق المغذّيات، ولا ينفكّون في كلّ ذلك عن تحذير البشريّة من عواقب اللّعب بالنار.
غير أنّ تحذيراتهم ظلّت أشبه بالصيحة في وادٍ؛ فتنامي نشوب الحرائق المروّعة نتيجة الارتفاع غير المسبوق لحرارة الكوكب، وتواصُل ارتفاع منسوب البحار بسبب ذوبان الغطاء الجليديّ، واضْطراب دَورة المياه مع تمدُّد مواسم الجفاف في الغابات المطيرة، والعجز عن التحكُّم في نِسب الانبعاثات الغازيّة في الغلاف الجويّ وتحديداً في مقادير ثاني أكسيد الكربون في الهواء، مع استمرار الاستخدام المُفرط للأسمدة في المساحات المزروعة، وتوسُّع الزراعة الكثيفة على حساب الحياة البريّة، كلّ ذلك يؤكّد أنّ البشريّة لا تلعب بالنار اليوم فقط، بل إنّها تعبث، وعلى صورةٍ مُفزعة، بالعناصر الأربعة جميعاً دونما استثناء.
الإنسان الأخير على الأرض؟
الخطير أنّ مقولة "نهاية التاريخ"، كما جاءت في المبحث الفلسفيّ لـ "فرانسيس فوكوياما"، قد لا تكون مجرّد تعبير مجازيّ يصف نهاية التطوُّر الإيديولوجيّ للإنسان نحو عَوْلَمة الديمقراطيّة اللّيبراليّة. فإذا اعتبرنا خطورة المؤشّرات المتعلّقة بالنُّظم الحيويّة على سطح الأرض، فمِن المُحتمَل أن يغدوَ توصيفُ الإنسان المُعاصر بأنّه "الإنسان الأخير" حقيقةً واقِعة. ذلك أنّ الأرض التي عَرفت خلال الـ 500 مليون سنة الماضية خمسة انقراضات جماعيّة، بدأت خلال العقود الأخيرة تكشف، وبنسقٍ مُتسارِع، عن وجهٍ عدوانيّ قد يُعجِّل بانقراضٍ جماعيّ سادس يُنهي هذه المرّة على نحوٍ مأسويّ تاريخَ البشر على سطحها.
ليس هذا السيناريو بعيداً. فبدايةً من الثورة الصناعيّة، شرعَ الإنسانُ يعمل بحماسة على إخراج الأرض من الاستقرار الذي عرفه أجداده خلال الـ 10 آلاف سنة الأخيرة. ووفقاً للتقديرات، قد يتوصّل جنسُنا البشريّ في غضون الأربعين سنة المُقبلة، إلى مرحلة غير مسبوقة، وهي التأثير في المُحيط المباشر تأثيراً يُغيِّر به وجه الكوكب كلّيّاً ويقضي قضاءً مبرماً على المؤشّرات المعقولة لحياةٍ آمنة.
فخلافاً لما قد يُتصوّر، لم تكُن الأرض على مدى تاريخها الطويل دوحةً يطيب بها العيش. فمن خلال رسمٍ بيانيّ، وَصَفَ فريقٌ من العلماء التقلّباتِ الحراريّة التي شهدتها الأرض على امتداد المائة ألف سنة الأخيرة، ليُبيِّنوا أنّ درجات الحرارة ظلّت على امتداد تسعين ألف سنة تتقافز ارتفاعاً وانخفاضاً بمعدّل عشر درجات كاملة بين العقد والآخر. وكان من نتائج هذا التفاوُت الكبير عدم استقرار منسوب البحار وغياب الحدود الواضحة بين الماء واليابسة. وبحسب تقديرات العُلماء، لم تَخرج الأرض من هذه الوضعيّة الفوضويّة إلّا يوم استقرّ التفاوُت الحراريّ بين العقد والآخر في حدود درجة مئويّة واحدة. حَدَثَ هذا الاستقرار قبل عشرة آلاف سنة، وكان من نتائجه الإيجابيّة أن أَدركتِ الأرضُ توازُناً ثميناً أعاد إنشاءها على الوجه الذي نعرفها به اليوم، وهو الوجه الذي أتاح الإعمارَ وقيامَ الحضارات البشريّة المُتعاقبة. غير أنّنا اليوم على وشك التفريط في هذا التوازُن الثمين الذي يزداد هشاشةً بين اللّحظة والأخرى.
الكربونة التي ستقصم ظهرَ الجليد؟
من المعروف أنّ الطّاقة الشمسيّة والانبعاثات الغازيّة هُما المصدران المسؤولان عن تدفئة الأرض طبيعيّاً. وخلال العشرة آلاف سنة الأخيرة، ظلَّ معدّل حرارة الأرض مستقرّاً بسبب استقرار تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجويّ، لكنّ الثورة الصناعيّة غيَّرت كلّ شيء.
فمنذ ثلاثة عقود تقريباً تجاوَزنا الخطوطَ الحمر المتعلّقة بالانبعاثات الكربونيّة والتي قدَّرها العُلماء بـ 350 جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون لنبلغ حاليّاً العتبة الخطيرة لـ 415 جزءاً من المليون، وانجرّ عن ذلك تفاقُم الاحتباس الحراريّ وتدفئة الأرض بما يزيد على درجة حرارة واحدة، وهو ما يُنذِر بإخراج الجنس البشريّ إخراجاً نهائيّاً، وفي غضون عقودٍ قليلة، من الحالة التي عاشت فيها البشريّة خلال الـعشرة آلاف سنة الماضية. فإذا استمررنا في إطلاق 40 مليار طنٍّ سنويّاً من أكسيد الكربون سينفد رصيدُنا الحيويّ من الهواء في غضون 7 سنوات في أحسن تقدير.
وفي الوقت الذي تقرأ فيه هذا المقالَ يُواصِلُ الغطاءُ الجليديّ القطبيّ المسؤول عن تبريد الكوكب عبر عكس حوالي 90% من الأشعّة الشمسيّة وإعادته للفضاء، ذوبانَهُ المُفزِعَ بمعدّل 10 آلاف متر مكعّب من الجليد في الثانية. وعلى الرّغم من الشعور العامّ بخطورة ما يحدث، فإنّ الوعي الجماعيّ لا يقدِّر عواقب هذا الأمر حقّ قدرها. فعلاوة على حتميّة ارتفاع مستويات البحار إلى ما يزيد على سبعة أمتار كاملة، بما سيلتهم المُدن الساحليّة التهاماً في غضونِ وقتٍ قصير، يؤدّي وجودُ سطحٍ سائلٍ على الجليد إلى تغيير لونه نحو البنّيّ الدّاكن، فإذا الصفائح الجليديّة ممتصّة للأشعّة الشمسيّة بدلاً من أن تكون عاكسة لها، وهو ما سيَجعلها مصدراً لمزيدٍ من تسخين الأرض بعدما كانت الضّامن لتبريدها. المُفزع أنّنا لا ندري متى يُصبح من المستحيل إيقاف سيرورة الذوبان، فمع استمرار المؤشّرات الحراريّة على ما هي عليه، قد تصل الصفائحُ الجليديّة في لحظةٍ ما إلى ما يُسمّيه العُلماء نقطةَ التحوّل الجذريّة، وهي النقطة التي يُصبح فيها الانهيارُ الكلّيّ للغطاء الجليديّ حتميّةً لا يُمكن تدارُكُها.
اقتصادٌ عالَميّ لدمارٍ عالَميّ
من الرسائل الإيجابيّة التي أرسلتها الأرضُ إلى سكّانِها بمناسبة جائحة كورونا إمكانيّة المُصالَحة بين الإنسان والطبيعة مُصالَحةً تقلِّل من مؤشّرات الخطر على الكوكب. فبمجرّد أن أصدرت الحكومات قراراتها بحظر التجوُّل وإيقاف النقل الجويّ أو تقليله إلى الحدّ الأدنى، وبمجرّد أن تعطّل الإنتاجُ المكثّف وتوقّفت الصناعات الملوّثة، تناقَصت الانبعاثاتُ الغازيّة المؤدّية إلى الاحتباس الحراريّ، وتحسَّنت جودة الهواء، وقلَّ تركيزُ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجويّ بشكلٍ يؤكّد أنّ التراجُع عن مَسار الخطر مُتاحٌ إذا توفَّر القرارُ السياسيّ العالَميّ الموحّد.
على أنّ ذلك الانفراج البيئيّ الذي وفَّره الوباء كان قصيرَ المدى؛ فسرعان ما عادت الأمور إلى نصابها الكريه مع عودة الحياة إلى نَسَقِها العاديّ. فبرجوع الحركة الجويّة والبريّة والبحريّة واستعادة المصانع أنشطتها المعطَّلة، عادت نِسَبُ ثاني أكسيد الكربون إلى الارتفاع مع ما يخلّفه ذلك من آثارٍ مدمّرة لا على سطح اليابسة فحسب، وإنّما على أعماق المُحيطات أيضاً. ذلك أنّه قد يخفى على غير المختصّ أنّ الثلث من الانبعاث الغازيّ الكربونيّ في الغلاف الجويّ ينتهي ذائباً في المُحيط فينتج عنه حمضُ الكربونيك، ويكون من آثار هذا الحمض، إذ يتفاعل مع كيمياء الماء، تغيير تركيبة المحيط وتقليل درجتها القلويّة، وهو ما يؤدّي إلى ما يسمّيه العُلماء تحمُّض المُحيطات.
وعلى العموم، لاحَظ العُلماء زيادةً في حموضة المُحيطات بحوالي 26% في العقود الأخيرة، وهي زيادة قد تفضي إلى انقراضٍ جماعيّ كارثيّ للكائنات البحريّة، ولاسيّما للرخويّات منها، وللغطاء المرجانيّ الذي بَدأ يضمحلّ بسرعةٍ جنونيّة متسبّباً في فناء النّظام البيئيّ المرتكز حوله. ويزداد طين البحار والمُحيطات تعفّناً، بما يصله من فوائض الأسمدة التي تُفرِط في استخدامها نُظُمُ الزراعة المكثَّفة. تتسبَّب تلك الأسمدة في إنتاج المزيد من الفوسفور بما يفضي إلى موت مناطق كاملة في أعماق المحيط. على أنّ التدمير المُمَنْهَج لا يقف عند ذلك الحدّ، فما زلنا إلى اليوم نصطاد أكثر من نصف المحيط بأساليب جائرة همجيّة تتسبّب في تجريف قيعان المُحيطات وتدميرِ الشُعَبِ المرجانيّة واستنفاد الكتلة الحيويّة للأرصدة السمكيّة وتهديد التوازن الهشّ للنظام البيئيّ البحريّ.
ثلاث محطّات تفصلنا عن الآزفة
من حُسن حظّ البشر أنّ الغباء المُسيطِر على طبقاتهم الرأسماليّة المتوحّشة لا تتقاسمه كلُّ الفئات. فقد تمكّنت طائفةٌ من العُلماء مكوَّنة من 26 باحثاً يقودُهم السويديّ يوهان روكستورم Rockstörm من رفْعِ الغشاوة عن عيون أصحاب القرار من خلال مجموعةٍ من المقالات ثوَّرت المُقاربات السائدة للأزمة البيئيّة. أَوجدت هذه المقالات مفهوماً جديداً هو "الحدود الكوكبيّة". يَرسم هذا المفهومُ الحدودَ الآمنة للنُظمِ البيئيّة التي يؤدّي احترامها والوقوف دونها إلى الحفاظ على استقرار الكوكب، ويحدِّد المؤشّرات التي يُفضي تجاوزها إلى نقاط اللّاعودة على مَسار التدمير الذّاتيّ. وعلى الرّغم من أنّ هذا المفهوم، بما حفّ به من أبحاثٍ داعمة وقياساتٍ وإحصاءات، قدَّم خارطةَ عملٍ واضحة للفاعلين في السياسات البيئيّة العالَميّة للخروج من الأزمة، فإنّ المؤشّرات الحاليّة لا تزال في تدهورٍ مستمرّ شاهدة على أنّ البشريّة تسير حثيثاً نحو المُنحدَر المؤدّي إلى فنائها. فمِن جملة تسعة حدود كوكبيّة ضَبَطَها العُلماء،ُ بوصفها الحدود الضامنة لحياةٍ سليمة على الأرض، تأكّد منذ العام 2015 خروج البشريّة من المساحة الآمنة المتّصلة بأربعةٍ منها وهي على وجه الدقّة الحدود المتّصلة بـ (1) المناخ و (2) التنوّع الحيويّ و (3) دورة المغذّيات من النيتروجين والفوسفور و (4) التربة.
فعلى المستوى المناخيّ، تجاوزنا بحوالى 65 جزءاً من المليون التركيزَ المسموح به من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجويّ، وهو ما سيؤدّي بالتدريج إلى رفْعِ متوسّط الحرارة في الأرض بـ 1،5 درجة، والأخطر أنّه ارتفاعٌ مرشَّحٌ للزيادة في السنوات القليلة المُقبلة.
أمّا في خصوص التنوّع الحيويّ، فالثابت أنّ 68% من تنوّع الكائنات قد أُزيل بالكليّة، علاوة على أنّ مليون نَوعٍ من النباتات والحيوانات من أصل ثمانية ملايين مهدَّدة اليوم بالانقراض بعدما فقدنا خلال عقود قليلة حوالي 40% من إجماليّ الغطاء الغابيّ. ويزداد الأمر خطورةً إذا اعتبرنا الانخفاضَ المُفزع في رصيد الطبيعة من الحشرات في عالَمٍ ترتكز فيه المحاصيل الزراعيّة بنسبة 70% على التلقيح الحشريّ، فضلاً عن العواقب الوخيمة المنجرّة عن المُبالَغة في حقْنِ التربة بالمغذّيات وما يحدثه ذلك من اضْطرابٍ في دَورات النيتروجين والفوسفور.
ولمّا كان ذلك كلّه غير كافٍ لاستثارة استجابة عالَميّة تُنقِذ ما يُمكن إنقاذه، فقد تجاوزنا بدءاً من العام 2022 حدَّيْن إضافيَّيْن يتعلّق أحدهما (5) بالتلوّث البلاستيكيّ والكيميائيّ وما يترتّب عنه من "خلق" عناصر جديدة في النظام البيئيّ تفسد اشتغاله السليم، ويتعلّق الثاني (6) بالمياه العذبة التي تناقصت بشكلٍ مخيف مع تمدُّد مواسم الجفاف في العالَم، بما في ذلك المناطق المعروفة بكثرة المُتساقطات.
لم تبقَ إلّا محطّات ثلاث تفصلنا عن الكارثة. محطّات تمثّلها الحدود الكوكبيّة التي لا تزال في المساحة الآمنة، وهي (7) مقدار تحمُّض المحيطات و (8) حالة طبقة الأوزون و (9) مقدار زيادة الهباءات في الغلاف الجويّ.
كيف نوقِف العدّ العكسيّ؟
تخيَّل أن يستفيق العالَم على تقريرٍ يؤكّد اقتراب نيزكٍ مُدمِّر يوشك أن يرتطم بالأرض. هل سيكون للعالَم شاغلٌ آخر غير العثور على حلٍّ للمشكلة مهما كانت تكلفة الحلّ؟ إنّنا في وضعيّة مُشابِهة الآن على الرّغم من الغفلة عن ذلك. ولا بدّ من استجابةٍ عالَميّة تجعل عدم تخطّي الحدود الكوكبيّة أولويّةً استراتيجيّةً مُقدَّمةً على جميع الأولويّات. في غياب ذلك التنسيق الجماعيّ العالَميّ، لن يسعنا إلّا مُراقبة العدّ العكسيّ وهو يأخذنا إلى النقطة الصفر: صفر إنسان على الكوكب الأزرق!
*أكاديميّة وروائيّة من تونس