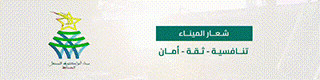مَنْ ليسَ له وطن، لا حياة له، ولا يعرف حقيقة وجوده الحيّ والفاعل، وربّما لا يعيش حالة التوازن الروحيّ والعمليّ الحقيقيّ في كلّ مفردات وجوده الخاصّ أو العامّ.. إنّه وطن الطفولة والشباب، وطن الأهل والأصدقاء، وطن الذكريات والعَيش المُشترَك والهويّة الإنسانيّة والتلاقي الحضاريّ. الوطن بهذه المعاني الواسعة والكبيرة، لا يستمرّ من دون محبّة وتعاون وتفاعل وتشارك حقيقي خصب ومُنتِج وبنّاء، وأيضاً من دون تضحية وفداء وبذل للغالي والرخيص مُرتبط بغايات النهوض النبيلة. وهنا تُصبح محبّة الوطن (والدّفاع عنه وقت الشدّة والمِحن)، بعيدة عن كونها مجرّد شعارات للاستهلاك الفارغ والتضليل الاحتوائي، بل تكون سبباً ومعياراً لبقاء الإنسان (المُواطن) مُعزّزاً مكرَّماً في المكان الذي وُلد فيه ونشأ وعاش بين أهله وناسه وطبيعته وقيَمه. فهو كلّ شيء.. يرتبط فيه الفرد بماضيه وحاضره، ليرسم وجوده ومَعالِم مستقبله التي يؤسِّس لها في حاضره. ولكن - من جهة أخرى - الوطن ليس معنويّاتٍ وقيَماً نظريّة وشعاراتٍ وأغانٍ للإنشاد واستعادة الأمجاد وتفجُّر الرومانسيّات فقط، بل هو مساحة جغرافيّة للعيش الآمن المُستقرّ المُفترَض أنْ تتوافر فيه مقوّمات الحياة الإنسانيّة الصلبة، وعلى رأسها وجود الحيّز الجغرافي المكاني، أي السكن الصحّي المُناسب والمُلائم للعيش الهانئ والسعيد الذي هو بدَوره أساس لإنتاجيّة الإنسان وفعاليّته وحضوره في عصره، وعطائه وتضحيته.
كان من أهمّ المشكلات الاجتماعيّة والسياسيّة التي حدثت في كثير من بلداننا العربيّة (التي انحازت للأدْلَجة والتأصيل العقدي الخلاصي بالذات، ومنعتْ تطوُّرَ مُجتمعاتنا في اتّجاه مَواقع النهضة والتقدُّم العصري)، عدم الاهتمام بموضوع أو قضيّة "التنمية العمرانيّة" الإسكانيّة، فكان هذا الانتشار الواسع والمُخيف للسكن المُخالِف أو ما يُسمّى بالسكن العشوائي، والذي ارتبط للأسف بسياساتٍ اقتصاديّة ديمغرافيّة وتنمويّة فاشلة وعديمة الجدوى اعتمدتها تلك النُّظم العربيّة.
وتُعرَّف العشوائيّات (أحياء ومناطق السكن العشوائي) بأنّها المباني السكنيّة التي أُقيمتْ بشكلٍ غير لائق وغير صحّي، وبلا أيّ تخطيطٍ أو نظامٍ هندسي وقانوني، وخارج نطاق خطط التنمية السكّانيّة للحكومات نفسها، وغالباً ما افتقرت وتفتقر (تلك المناطق) إلى كثيرٍ من الخدمات والبنى التحتيّة الأساسيّة المُفترَض تنفيذها بشكلٍ عِلمي ومهني مدروس ومخطَّط له، ومُلائم لحياة الإنسان وعَيشه المُنتج، وتطلّعه للازدهار والسعادة والرفاه المادّي. وحتّى لو تمّ تأسيس خدمات أساسيّة فيها (في تلك الأحياء العشوائيّة) فإنّها قد لا تكون بالمستوى الفنّي والهندسي والصحّي المطلوب!
وهذه الكتل العشوائيّة أو الأحياء السكنيّة المُخالِفة، انتشرت وتنتشر في بعض بلداننا العربيّة، لتشكِّل بحجْمها ومساحتها النسبة الأكبر من أحياء المُدن (حتّى باتت تُعرف بمُدن الصفيح أو مُدن القاع).
بطبيعة الحال لم تنتشر مناطق المُخالفات العربيّة هكذا فجأة ومن دون سابق إنذار، بل هي امتدّت وتضخّمت في مدىً زمنيّ غير قصير، على مَرأى السلطات والنُّخب والحكومات القائمة ومَسمعها، وتعاظَم مدُّها العشوائي المُخيف من دون أيّة محاولات جديّة من قِبَلِ هؤلاء (ومؤسّساتهم وهياكلهم الهندسيّة والإداريّة المَعنيّة) لمنْع انتشارها، ولتنظيمها وإسكان الناس فيها بصورةٍ حديثة وسليمة ومأمونة وصحيّة، شكلاً ومضموناً.
طبعاً، لا نريد التعمُّق في فهْم الأسباب والدوافع التي مَنعتْ أو أَعاقت تطوير تلك المناطق العشوائيّة حتّى قبل أن تكبر وتمتدّ وتتوسّع وتتعقّد مُعالجتها وحلولها، ولكن باختصار، يأتي على رأس تلك الأسباب، هَيْمَنة الفساد وعدم وجود استراتيجيّات تنمويّة عِلميّة صحيّة وصحيحة وفعّالة! حيث تُرك الناس - وهُم بعشرات الملايين - لأقدارهم البائسة دونما أيّ تدخّلٍ نَوعي وفنّي وقانوني ملموس من قِبَلِ المؤسّسات الحكوميّة المعنيَّة لحلّ مشكلة البناء المُخالِف والسكن العشوائي. مع أنّه كان بالإمكان إيقاف تفشّي تلك العشوائيّات – البعيدة عن أدنى معايير السلامة الفنيّة والصحيّة والعمرانيّة - منذ عقود طويلة، قبل أن تمتدَّ وتتوسّع أفقيّاً وعموديّاً على حساب الأراضي الزراعيّة، بحيث أصبحت مُعالجتها صعبة وربّما غير مُمكنة حتّى في المديات القريبة.
غياب أُسس التنمية الصحيحة
إنّ غياب أُسس التنمية الصحيحة المُتوازنة، وتغييب مقوّمات التخطيط العلمي الرصين، وتفشّي اقتصادات الظلّ غير المُنضبطة في تلك البلدان، هي جملة عوامل اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة متداخلة، أسهمت بكليّتها في خلْق بؤرِ التهميش التنمويّ والعمرانيّ المسبوق بالتهميش السياسي والعملي، ومبانيه وثقافته وواقعه.
والسكنُ العشوائي كسكنٍ رخيص وبديل عن السكن الحضري (الذي هو سكن مُلائم للصحّة والسلامة والأمان)، لم يلجأ إليه الأفراد من ذوي الدخل المحدود، لو توافرت (أو تتوافر) بين أيديهم ظروف العمل المناسب ومآلات التنمية الصحيحة، المُفترض أن تتهيّأ لهم من قبل الحكومات المسؤولة عن حياتهم ومعيشتهم وتهيئة مناخات عملهم الفاعل والمُنتج.
إنَّ الفقر المادّي وانعدام القدرة والكفاية الاقتصاديّة على حيازة رأس المال الكافي للحصول على السكن الصحّي المناسب، هو الذي يدفع الإنسان (الفقير أو المفقّر) في اتّجاه البناء العشوائي أو البحث عن سكنٍ له ضمن تلك الأحياء العشوائيّة التي نَمت وكبرت وتضخّمت حتّى باتت مشكلة تنمويّة وعمرانيّة واقتصاديّة مُكلفة للغاية؛ حيث جاء نموّها وتضخّمها في غفلة (مقصودة بلا شكّ) من المسؤولين المعنيّين المُستلمين لزمام الأمور.
وبطبيعة الحال لا يُمكن توجيه اللَّوم أو تحميل المسؤوليّات - عن نموّ تلك المناطق - للناس أنفسهم، من الفقراء والمهمَّشين. وأيّ تفسير يُحاول لَوم الفقراء وتحميلهم مسؤوليّة ظهور مشكلة السكن العشوائي، وما يرافقها من أمراضٍ اجتماعيّةٍ أخرى، هو تفسيرٌ مَرَضيّ يتجاهل وينكر - عن سابق قصد - الأسباب الجوهريّة الأخرى الكامنة في تلك السياسات الاقتصاديّة والخطط التنمويّة التي اتُّبعت في تلك البلدان، والتي كانت بمجملها عقيمة غير مُنتجة كما قلنا سابقاً.
إنّ القدرات والطاقات والخبرات وضرورة خلْق فُرص العمل، وتطوير الخبرات ونوعيّتها، كلّها عوامل مهمّة في تحسين شروط الإسكان والعمران المادّي وحتّى التنموي والعقلي.
طبعاً للأسف، لم تُبالِ معظم الحكومات المعنيَّة بأمر تنظيم عمران بلدانها، بالعكس فقد أسهمت - نتيجة فساد نُخبها ومؤسّساتها المنخورة حتّى العظم بالمحسوبيّات والاستزلام والزبائنيّة الاقتصاديّة والسياسيّة - في امتداد واستشراء تلك العشوائيّات لغاياتٍ تتّصل بالوظيفة "الاجتماعيّة - السياسيّة" لتلك العشوائيّات كأنساقٍ معقّدة داخلة ضمن النظام الوظيفي العامّ الذي تعتمده تلك السلطات الحاكمة، بحيث يُمكن القول إنّ ذلك الامتداد العشوائي كان عبارة عن سياسات متعمّدة من طرف نُخب الحُكم لإبقاء المُجتمعات رهْن حاجاتها الأولى، حتّى يسهل إخضاعها واحتواؤها، ومن ثمّ استغلالها (واستخدامها وتجييرها) في أغراضهم الأخرى.
طبعاً، العشوائيّات المكانيّة هي جزء من عشوائيّات أكبر وأكثر خطورة، ولو لم تكُن قائمة وموجودة ما وصلنا إلى الأحياء العشوائيّة، ونعني بها، عشوائيّة الفكر والعقل والتفكير، والامتناع عن التصرُّف بمسؤوليّة وعلميّة وعقلانيّة من قِبَلِ القائمين بأمر تلك المُجتمعات.. فاستشراء الفساد، وسياسة شراء الذّمم والولاءات، وتمكين الأزلام، وإنفاق الأموال الطائلة على عسْكَرة المُجتمعات، وتسليح الجيوش وبناء الأجهزة الوصائيّة التي تحبس أنفاس الناس، وتمنعها بالقوّة والعنف من الوصول لحقوقها الجوهريّة... كلّه أَسْهَمَ وبقوّة في استدامة تلك الأزمات واستمرارها، وعلى رأسها أزمة بقاء مُجتمعاتنا مرهونة لتخلُّفها وإعاقتها التنمويّة والحضاريّة، بما منعها من البناء والاستنهاض والتقدُّم الحقيقي المدني والعمراني والحضاري.
وما لم تتغيّر بنية وماهيّة تكوين تلك الدول المؤدلَجة القائمة، في اتّجاه بناء دول ديموقراطيّة حديثة، لن تتحسّن شؤون مُجتمعاتها وأفرادها على أيّ صعيد من الأصعدة، حيث إنّ طبيعة الدول الحديثة اليوم باتت دولَ خدمات لا دول فكرٍ متحجّر وأيديولوجيّاتٍ وهويّاتٍ مُغلقة.. دول تُشرف وتخطِّط ولا تُهيمِن ولا تُسيطر على المجال العامّ.. دول تُتيح وتُفْسح وتُهيّئ الأجواء والبنى، دول لا تتسلّط ولا تنحاز ولا تتملّك. فمقتل الدولة (أيّ دولة) يأتي عندما تتحوّل إلى مجرّد مُضارِب سياسيّ أو اقتصاديّ أو ماليّ...إلخ.
لقد ضاعتْ كثيرٌ من خطط التنمية الاقتصاديّة والعمرانيّة في تلك البلدان - التي ضَربتها واجتاحتها العشوائيّات (التفكيريّة والعمرانيّة)، والمُفترض أن تبني (أي تلك الخطط) مَواقِع قويّة للازدهار والتطوُّر الحقيقي - عندما ضاعت أو تمّ تضييع حقوق الناس. وما لم تَعُد تلك الحقوق وتتفعّل، لن تُستعاد نهضة المُجتمعات العمرانيّة والتنمويّة.
نبيل علي صالح
كاتب وباحث من سورية