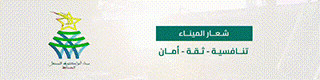في عام 1960، كنت عاطلا عن العمل. وكانت العروبة نفسها عاطلة عن العمل، ويا ليتها ظلت كذلك، وكنت حينذاك ضيفا على مجلة "شعر"، وأسرة التحرير كلها ضيفة على صاحبها يوسف الخال، ويوسف الخال ضيفًا على شارع السادات في رأس بيروت. في هذه الأثناء حل بدر شاكر السياب (بأناقته المعروفة) ضيفًا على الجميع، وهو يمشي قدمًا في الشرق وقدمًا في الغرب بسبب تباشير الروماتيزم في ركبته، ولما كان بريئًا وساذجًا، ولا يعرف أن يتحرك بمفرده فقد كلفني يوسف الخال بمرافقته طوال إقامته هناك، وأوصاني وهو يسلمني إياه: لا تعذّبه، إنه شاعر كبير.
ومن أول المشوار توطدت عرى الصداقة فيما بيننا، خاصة بعد أن أهداني في لحظة انفعال كرافيت من نوع سيلكا أو سمكا، لم أعد أذكر، عربونًا على صداقتنا الأبدية، وبدأت مهمتي في اطلاعه على الحياة الثقافية في بيروت، فأخذته من ذراعه وقلت له: هذا هو الشارع الفلاني، وهذه هي السينما الفلانية. في هذا المطعم يجلس أركان الناصريين ليهاجموا القوميين، وفي هذا المطعم يجلس أركان القوميين ليهاجموا الناصريين والشيوعيين. وفي هذا المقهى يجلس أركان مجلة "شعر" ليهاجموا الجميع، متخذًا كل واحد منهم أفضل طاولة وأفضل واجهة من الصباح إلى المساء على فنجان قهوة وخمسين كأس ماء بنصف ليرة. وعند هذه الزاوية بالذات سحبني صاحب المقهى من يدي وقال لي: إما ان تخلصني منهم، وإما أهدم المقهى وأحوله إلى محل لبيع الشاورما، كرمى ليوسف الخال وشعره الحديث.
وكان بدر يضحك كالأطفال من هذه المعلومات، وكنت بدوري أكثر سعادة منه وأنا أقوم بمهمتي خير قيام لصالح الشعر والحرية، حسب مفهومي. ولكن ما إن انتهينا من الشوارع العريضة والمناطق السكنية، وبلغنا منطقة الأسواق التجارية والشوارع المزدحمة بالواجهات والمتفرجين، حتى أخذت بعض المتاعب تواجهني في مرافقته، فقد اكتشفت أن المسكين لا يستطيع التسكع كالمراهقين أكثر من عشر دقائق أو ربع ساعة، بعدها يأخذ في الترنح والدوران حول نفسه وحول مرافقه، ولذلك كنت أجده في لحظة على يميني، وفي اللحظة التالية على يساري. وعندما لا يجد مرافقه إلى جواره، يدور حول أي شيء، حول عمود كهرباء أو شرطي سير، أو حول نفسه. ويتابع طريقه وحديثه عن الشعر الحديث والشعر القديم. وفي باب إدريس حيث رافقته لشراء بعض الهدايا لأم غيلان أتعبني أكثر من ثلاثة صفوف في سن الحضانة، إذ ما إن يمر بزقاق أو زاروب فرعي حتى يترك طريقه الأصلي ويسلكه، وما إن يرى أي باب مفتوح حتى يدخله، باب دكان أو باب مستودع، ويتابع حديثه عن صلاح عبد الصبور وعمر أبو ريشة.
مثلًا، فيما نحن نهم بدخول "نوفوتيه"، يدخل هو صيدلية أو مكتب طيران أو فرن كاتو. وعندما زادها بعض الشيء قلت له أمام المارة، إما أن تظل ملازمًا لي في كل خطوة وفي كل اتجاه، وإما أن أمسك بيدك أو أربطك بخيط وأعرّف قرّاءك عليك وأنت في هذا الوضع.
لكن في الأمسية الشعرية التي أحياها مساء في بيروت، انقلب إلى شخص آخر لم أعرفه ولم أرافقه خطوة واحدة من قبل. حتى إنني عندما رأيته يحدق بالحضور فردًا فردًا بكل ثقة وثبات، خفت منه. وانتقلت من الصف الأول إلى الصف الثامن أو التاسع. ومن هناك أخذت أراقبه، كان كل ما فيه كبيرًا، قلبه، موهبته، رأسه، أذناه، ما عدا جسمه. كان المسكين رأسًا.
وعندما تقدم من الميكروفون تحت الإضاءة نصف الخافتة، لمحت ملامحه كلها، ولم يبق بارزًا منها أمام الجمهور سوى أسنانه، كانت جاحظة من خلال شفتيه بوضوح فيزيولوجيًا وأيديولوجيًا حتى كادت تغطي الصف الأول من الحضور. ووسط الصمت المطبق، صرح بقصيدته الجزائرية الشهيرة "من قاع قبري أصيح حتى تضج القبور". وما إن انتهت الأمسية حتى كنت في الصف الأخير بسبب تدافع المعجبين والمعجبات للوصول إلى الشاعر الكبير، شاعر الحرية والثورة الجزائرية مُقرِّظين مهنئين. ولكن ما إن سلمت عليه أول معجبة وهي تتنهد حتى ارتخى، وأخذ يصرفني من بعيد بإشارات متلاحقة من يده. وكلما ازداد عدد المتحلقات من حوله بثيابهن الفاخرة وعطورهن المثيرة، ركبه الغرور أكثر وأكثر، وراح يحلق في أجواء من المواعيد الوهمية والأجواء الكاذبة. إذ قال لي ما معناه، بأنه يعتذر عن مرافقتي تلك الليلة وربما لا يستطيع أن يراني أو يرى غيري حتى بعد يومين أو أسبوعين. وعاد لتبادل كلمات الإعجاب والإطراء مع المتحلقين من حوله. ولما كانت السماء ممطرة، وأعرف جيدًا هذا النوع من الانبهار وتبادل العواطف والمجاملات أثناء ارتداء المعاطف والتهيؤ للانصراف على أبواب النوادي والمراكز الثقافية، فقد أشفقت على بدر.
كان المطر ينهمر، والرؤية فوق البحر وفي الشوارع، عندما أخذت مصافحات الوداع والتمنيات باللقاءات في مناسبة أخرى تتوالى على مسامع الشاعر الكبير مع انغلاق أبواب السيارات وانطلاقها بمعجبيها ومعجباتها في ظلمات بيروت الساهرة. وبقي بدر خارج القاعة وحيدًا كالميكروفون في داخلها. وفجأة نسي كل شيء. وأقبل عليّ يدور حول نفسه كعادته، ووضع ذراعه في ذراعي وانطلقنا باتجاه منطقة البارات ضاحكين ساخرين. وفي الطريق أخذ يحدثني عن زيارته الأخيرة لإيطاليا، وعن شغفه الجديد بالمعكرونة، ثم انتقل من المعكرونة للحديث عن شعر عبد الوهاب البياتي. ومن ثم عاد للحديث مرة أخرة عن إيطاليا، ثم انتقل إلى ثرثرة المضيفات، وعن ولعه بالبحر، وتصميمه على تعلم السباحة بالمايوه. ثم انتقل من الحديث عن السباحة إلى الحديث عن ثورة الشواف في الموصل. وعندما قلت له: وما علاقة هذا الموضوع بحديثنا؟ نظر إليّ عابسًا وقال: هات الكرافيت.
وفي البار تولى بدر شؤون السهرة. فأوقعنا بين يدي غانية إيطالية دوختنا قبل أن تحضر كؤوسنا دون أن نأخذ منها حقًّا أو باطلًا، وخاصة أن بدر من أول كأس لم يعد يعرف روما من بورما. حتى إذا جاء آخر الليل لم يكن معنا قرش واحد إلا ودفعناه على مائدتها. ثم انصرفت مع بدر وهي تدعي الوقوع في غرامه من أول نظرة والإخلاص له إلى الأبد.
وغادرت البار ولحقت بهما متباطئًا دون أن يغيبا عن ناظري. وبينما كان بدر يرقص ويدور حولها كعادتها، ويغني لها الأغاني العراقية بصخب الطفال، وإذ به يصمت فجأة ويختفي، وعلى الرصيف المقابل فوجئت به يجلس القرفصاء وحيدًا على عتبة فندق، فسألته، ماذا تفعل هنا؟
ـ انتظرها.
ـ وأين ذهبت؟
- صعدت إلى غرفتها لتغير ثيابها.
ـ وإلى أين ستذهبان بعد ذلك؟
- لا أعرف.
فسحبته من يده وقلت له منفعلًا، قم وكفاك جنونًا، امرأة على هذا القدر من السكر والنعاس، أتظنها قادرة على تبديل ثيابها والتبرج لجنابك في هذه الساعة من الليل. أؤكد لك أنها لن تصل إلى غرفتها حتى تنام على لحافها وحقيبتها في ذراعها. فقال بدهشة، غير معقول، لقد وعدتني.
فقلت له: ومن هي التي وعدتك؟ سهير القلماوي، أنديرا غاندي؟ قم ولا "تشرشحنا" أمام الناس لقد طلع الفجر.
ونهض، ومر بنا حارس ليلي فقال: ماذا تفعلان هنا؟ فقلنا له: لا علاقة لك بهذا الأمر. نحن من روّاد حركة الشعر الحديث.
وانطلقنا في أول تاكسي باتجاه الفندق، ولكن في اللحظة التي وصلنا فيها وصل ترامواي وتوقف فترة هناك لجمع الركاب. وبعد أن ودعته، مضيت على أساس أن هذه الليلة انتهت على خير، ولكنه، وبدلا من دخول الفندق، دخل الترامواي وانطلق به، وأظن أنه بهذه الطريقة دخل الحزب الشيوعي من قبل.