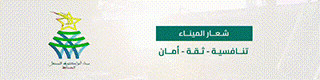حول موضوع تفشي الجريمة في انواكشوط، تناولنا أنا و صديق عزيز، عاش قبل هذا. في صحاري دولة مجاورة، أطراف حديث شيق، فيه قليل من البكاء على الأطلال.
بالنسبة له، نحن خليط غير متجانس من الناس، خليط من جيلين… من عصرين… من عالمين مختلفين…!
إن بعضنا بالنسبة له، كمياه النهر عند التقائها بالمحيط : بقية عذوبة قبل الانصهار الأبدي في عالم الملوحة…!
المحيطاته المالحة بالنسبة له، هي الحياة الجديدة التي بلورها زمن “الهايتك” و “اسمارتفون” و ما تلى ذلك من انجراف عارم نحو بعد افتراضي جديد… و قد أطلق على أجيالنا كلها، إسم أجيال دات كوم (com.) !
أما المياه العذبة، فهي بالنسبة له، تلك الحياة الطبيعية العتيقة. التي قال عنها ما يلي : “كانت الحياة التي أدركت هي الحياة الحقيقية ! فيها السكينة و الإطمئنان…فيها عمائم تلائد كانت وقارا بهيا و قدوة يتسابق إلى حذوها… فيها أمهات كانت حضنا دافئا… يحمين و يوجهن نحو جادة الطريق، عبر قصص طريفة تروى كل ليلة، قبل كل نوم، عند سكون الليل.
منازلنا الطينية العادية لم تكن باهتة أبدا. باحاتها الفسيحة كانت حية بأشجار مثمرة وارفة، و كانت حية بقراءة الأطفال للقرءان الدائمة و كانت كذلك، حية بما يشبه تعبدا من نوع آخر، يكمن في تربية راقية لحيوانات أليفة جميلة… و ما صورة ذلك الطاووس الملكي الزاهي العالقة حتى الآن في ذهني، رغم مرور عقود كثيرة، إلا دليل على افتتاني بذلك الزمن الجميل…
أما بيوتنا فقد كانت، هي الأخري، بحق و جدارة، بمثابة مراكز ثقافية تعج بكتب موروثة أبا عن جد، هذا و قد زينت جدران تلك البيوت بلوحات جميلة تمجد السيرة النبوية الشريفة، في ما يشبه معارضا صغيرة للتراث الإسلامي لا تكاد تخلوا منها دار من ديارنا.
في الخريف، خارج الديار، في البراري القريبة، مروج ساحرة تتجول عليها أبقارنا الكريمة. وهي تلك الأبقار التي نكاد نقدسها امتنانا منا لإطعامها لنا دون من أو كلل أو ملل منذ غابر الزمان …”
و قد تذكر صديقي، كل هذا اليوم، ليبرأ زمانه من أفعال زماننا المقيتة. فمن سابع المستحيلات، أن يتصور في عهده ذاك، أن يوما ما ستصل الجريمة إلى درجة يقتل فيها شيخ من قومه، بدم بارد، و هو في طريقه إلى بيته حاملا معه طعاما لأطفاله…تماما كما فعل قتلة توجونين، في بحر الأسبوع الماضي، عليهم من الله ما يستحقون.
و بناء على هذه المحادثة الكريمة، أريد أن أنوه الي نقطتين.
الأولى تخرج قليلا عن سياق النص و اقتصاده، لكنني عزمت على إلصاقها به، لإعادة الوسم إلى مكانته اللائقة و إعادة الاعتبار إلى الأمور التي تستحق ذلك؛ فعلينا أن نعترف حقيقة ،أن في محيطنا الصحراوي (و النسبة هنا للصحراء الكبرى)، عكس ما يعتقده الكثيرون منا، توجد فعلا، منظومة ثقافية راقية و عريقة بكل المعايير، تستحق منا، كل الإعجاب و التقدير و المحبة. إنتهى الإلصاق.
النقطة الثانية (و هي في السياق هذه المرة) : أن الحياة انقلبت فعلا ظهرا على عقب. فقبل هذا الغزو التكنولوجي الرهيب العارم، كانت الحياة رائعة… كان الناس يستمتعون بها و كانوا يتوادون فيها. و قد تسنى لهم فعلا، أن يعيشوا كبرياءهم و شموخهم… عكس اليوم، الذي يجري فيه كل واحد منا في سباق محموم من أجل البقاء، لا قيم و لا هم يأبهون. همه الوحيد، هو تسليم شعلة الحياة مهما كانت خافتة لأبنائه من بعده، ليواصلوا بدورهم، الركض كما كان يفعل، ليسلموها هم الآخرون، لأبنائهم من بعدهم… و هلم جرا.
نحن فعلا وقعنا على رؤوسنا في زمن “الهايتك” هذا، فقد تفشى فينا جفاف المشاعر و كثر الجفاء و ساد الحرمان و طغى انحلال الأخلاق و انتشرت المخدرات و تعددت جرائم القتل البشعة…ولابد أن هناك أسباب ‘تقليدية’ أخرى تغاضيت عن ذكرها عمدا لإبراز خطورة الهايتك و منظومة الفضاء الافتراضي (cyberespace) على نسيجنا الاجتماعي الطبيعي.
إن مخاطر هذا التطور الجديد و عواقبه الفتاكة لا يمكن حقيقة و حكما، تفاديها دون مواكبته بسياسيات حازمة تكون على قدر مستوى حدثه، و ذلك قبل فوات الأوان… فالعالم و نحن جزء منه، دخل فعلا، في منعرج ثورته الصناعية الرابع ( ‘Cyber Physical Systems ‘4.0) …
أما سياسات الزمن الجميل، فقد ولى زمانها إلى غير رجعة. و من يعتمد عليها اليوم في محاربة آفات الزمن من جرائم و غيرها، كمن يستخدم الخيل والرماح لمقاومة غزو بالطائرات و الصواريخ الذكية….
سيد احمد بابه